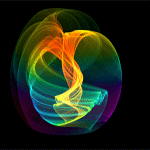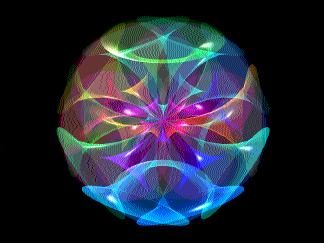الأربعاء، 30 نوفمبر 2011
الأربعاء، 23 نوفمبر 2011
الأحد، 20 نوفمبر 2011
الإقتصاد في الإنجيل - القسم الثالث = الحياة الإقتصادية والحياة الأبدية
القسم الثالث
الحياة الاقتصادية
والحياة الأبدية
يقاربُ هذا القسم، لكنْ بتصرُّف وزيادة للآيات موضوع الاستشهاد، الفصلَ الثاني من كتاب
L'Evangile, le chretien et l'argent
للكاتب Pierre de Lauzun – منشورات cerf – باريس 2003
الفصل الأول
الاقتصاد في العهد القديم
الثروة ، تصوّر مسبق لواقع آخر
يظهر التحوّل الرئيس في العهد الجديد في شكله الأوضح. لكن مهمٌّ أوّلاً الأخذ في الاعتبار كيف عالج العهدُ القديم المسألة ذاتها. لأن العهد الجديد لا يأتي من لا شيء، وحتى أنه لا يُطيح بالقديم، ولكنّه ينطلق منه ويهدف إلى تطبيقه. وحتى عندما يكون العهد الجديد أكثر ابتكاراً فالجذور ظاهرة في القديم.
لقد وُضِعَ العملُ في مكان محوريّ وأساسيّ في الكتاب المقدّس كلّه، بما يشكّل مصدر سعادة، وهو مثمرٌ لمن يسلك طرق الربّ. ولكن في الوقت ذاته، وبفعل السقوط، يحملُ العملُ بُعداً مؤلماً: لا يأكل المرء إلاّ بعد أن يشقى، وخصوبته على هذه الأرض أقلّه، ليست مؤكّدة. إضافة إلى ذلك، فالثروة التي يقدمها الله، وتنتج تاليًا عن العمل، تظهر أنها جيدة في ذاتها. ونرى في استمرار ظهور أشخاص ميسورين، تٌعتبر ثرواتهم هبة إيجابية من الربّ. ويقال أيضا إن الثروات هي في منزل الصالحين. لكن أين يجب أن نتوقع الحصول على هذه الثروات وننتظرها، هل في هذا العالم ماديًا أم روحياً وفي العالم الآخر؟ يبدو أن النصوص العديدة تؤدي إلى التفسير الأول: الثروة ههنا مكافأة دنيويّة. وكان هذا الفهم طبيعيًّا جداً في المراحل الأُولى من النبوءة، بخاصةًٍ مع الوعود التي قطعت لإبراهيم وموسى، بما يتناسب مع رؤية شعب الله وأرض الميعاد، التي كانت في هذه المرحلة تتحقّق ماديّاً في الزمان والمكان. بل ويمكن القول أيضاً في هذا الموضوع أنّ العهد القديم، الذي يعود الى العبرانيين تاريخيًا، مقارنة مع العهد الجديد الذي افتتحه يسوع، هو مثل الحقائق المادية مقارنةً مع ما يتعلّق بها من رسالة روحيّة، ما يُشكّلُ تصوّرًا دنيويًّا لواقع يتخطّى جذريّاً هذا المنظور الدنيوي. ولمجرّد كون هذا التصوّر الماديّ لشيء آخر أساسيّ، يُعتبر بالتالي واقعًا ذا مغزى كبير: فالله حاضرٌ وذو فعلٍ في كلّ أحداث العهد القديم التي تتمحور حول أرض الميعاد المرسّخة في الوقت والزمان، أو حول ثروة أو يُسرٍ ماديّ أيضًا. هذه الحقائق الدنيوية قادرة إذاً على تصوّر الحقائق الأساسية التي تظهر تدريجياً، فهي تملك تاليًا منصباً نسبياً معيّناً، وقيمة جوهرية، إضافة الى أن الله اعتبر من الجيّد، ليس فقط لأسباب تعليمية تربوية، المرور في تلك المرحلة التاريخية الطويلة قبل التجسّد.
ثمار الثراء المرّة
لقد استنتج العهد القديم ذاته أنّ الثراءَ الماديَّ مصدرُ سيئاتٍ وانحرافات عديدة وخطيرة، بما فيها الجشع، الذي يدفع الى الخطيئة. ونلاحظ أن الغنيّ يقلق على ثروته في شكل خطير، وهو أيضاً معرّض الى التكبّر والبخل. فالبحث عن الثروات هو عموماً أمرٌ مُحبِط، قد نفشل أو ننجح فيه. وفي شكل أعمق، ليس الثراءُ سوى مُلْكٍ منخفض التراتبية. لطالما كان الثراء والفضيلة أمران لا يلتقيان. ويذهبُ المرء عموماً الى الغنيّ وليس الى الفضيل. والأمر الأكثر فظاعةً، أنّه غالباً ما يكون الملحدون أثرياء ومزدهرين مادياً. إنّ نصوصًا كثيرة تعلن عن عقوبة الغنيّ السيّء الذي يتباهى بثرائه، أوعن إفلاسه. ولكن متى وكيف؟ ويظهر الجواب تدريجيا في تخطّي المشكلة وفَهم أن المسألة الرئيسة لا تكمن هنا، أقلّه ليس في منظور محدود بهذا العالم. المهمّ هو أن الثروة المادية هي في جوهرها عابرة. ما نفع التكبّر والثراء، وهما يختفيان مثل الظلال؟ وعلى أيّة حال، لا تنفعُ الثروة المادية بشيء بعد الموت. فالرجل الغنيّ الذي يموت لا يمكنه أن يأخذ معه أيّاً من ثرواته، ولو كان حافظ عليها طوال حياته. ولا تنفع الثروة الماديّة شيئاً في يوم الدينونة. والأمل بعد ذلك يكمنُ في رحمة الله الأبدية وحدها.
الحكمة أكثر من الثروة
حتى في هذا العالم، لا ينبغي أن تكون الثروة قيمة أساسية، حتى لو كانت هبةً من الله، الذي يجب أن نكون ممتنّين له. لا ينبغي أن يتباهى الغني بغناه، ولكن فقط بأنّه يخشى الربّ. وما نحتاج إليه عملياً في ما يتعلق بقضية الثراء: القرارَ الحكيم. إنّ الخطر موجود في الحالتين: يمكن للفقر أن يؤدي إلى الجريمة، ويمكن أن يؤدّي الثراء بفعل الغطرسة والغرور الى نكران الله، ولكن أمام معضلة من هذا القبيل، يجب على العادل تفضيل الفقر على ثراء الخاطئين. والاستنتاجُ الرئيس في نهاية المطاف هنا، أن الأمر الوحيد المهم أمام مسألة الثروات، التحلّي بالحكمة. فسليمان الملك على سبيل المثال، لم يسأل الله الثروة والسلطة، ولكن تحديداً هذه الحكمة، وكان الله "ممتنًّا" لهذا الاختيار، فأعطاه الاثنين معاً (سفر الملوك الأول الفصل الثالث 1 – 15) " فحسُنَ في عيني الرب أن يكونَ سليمانُ قد سألَ هذا الأمرَ. فقال له الله: بما أنّكَ سألتَ هذا الأمر، ولمْ تسألْ لكَ أيّامًا كثيرةً، ولا سألتَ لكَ الغِنى، ولمْ تطلب نفوسَ أعدائكَ، بل سألتَ لكَ التمييزَ لإجْراء الحكم، فهاءَنذا قد فعلتُ بحسبِ كلامك. هاءَنذا قد أعطيتُكَ قلبًا حكيمًا فهيمًا، حتّى إنّه لم يكنْ قبلكَ مثْلُكَ ولا يقومُ بعدكَ مثلك. وحتّى ما لم تسأله قد اعطيتُكَ إيّاه من الغِنى والمجد، فلا يكونُ رجلٌ مثلُكَ في الملوكٍ كلَّ أيّامِكّ. وإنْ أنتَ سِرتَ في طريقي حافِظًا فرائضي ووصاياي، كما سارَ داود أبوكَ، أطيلُ أيّامكَ".
الواجب الأساس تجاه الفقراء
ويظهر تاليًا عنصر أساس آخر، ألا وهو العلاقة مع من لا يملك هذا الثراء: الفقير. فعلى الغني هنا واجب أساس. وويلٌ للذي ليستْ لديه شفقة على الفقراء ولم يعطهم! وفي وصف صورة فضائل الرجل السعيد، نجد في شكل بارز الرحمة والمساعدة المقدّمة إلى الفقراء. من يُشفق على الفقراء، يكرّم الله. ومن لا يستمع إلى الفقراء لن يستمع إليه الله. فالاحسان الى الفقراء واجب، وله مبادئ ووسائل: الأول أن نكون شرفاء وصادقين، ونحسنَ إلى الفقراء الذين نستخدمهم بمن فيهم الأجراء. يجب أن يُدفع الى الفقراء سريعًا، لقاءَ ثمرة أعمالهم. ويقضي المبدأ الثاني بألاّ يسعى منْ يملك أموالاً، الى الحصول على كلّ شيء أو أن يستعيده بنهمٍ وشره. وتنصّ شريعة موسى على أنّه خلال السنوات البور، يجب أن يكون الفقراء قادرين على جني ما ينمو بحرية. كما يجب ترك حصّة الفقير في الحصاد ذاته، من دون استعادة كلّ شيء تلقائياً.
وتوجد مجموعة ثالثة من الوسائل، أكثر أهميّة جوهريّاً، هي الإقراض والفائدة الربويّةٍ. في هذا النوع من الاقتصاد، في الواقع، كان الاقراض ذو الفائدة يعتبر ربويًّا الى حدّ بعيد، ويرتبط بصورة عامة بفقر المقترض. لأن هذا الأخير لم يكنْ ليقترض إلاّ لأنّه لم يكن لديه المال لتأمين معيشته. فالممنوع ليس الاقراض، ولكن كلّ ما يجرّده من طابعه بهدف المساعدة. يقول القانون: لا ينبغي طلب الفائدة على القروض الممنوحة إلى الفقراء، ويقضي بالإعفاء العام من الديون كلّ سبع سنوات، ولا يسمح للمقتدرين بأن يتذرّعوا بعدم الاقراض عند اقتراب العام السابع: فالقرض المماثل هو في الواقع واجب. يجب الاقراض مجاناً، من دون التفكير بعرفان الجميل. أمّا الوسيلة الرابعة فهي الأكثر كرماً وهي الصدقة. بمعنى آخر، الإعفاء من الديون جزء من الصدقة. فالصدقة واجب، وفقاً لحجم الثروة، ولا يجب حرمان الفقير من الصدقة المتوجبّة. وعلاوة فإنها تساهم في التكفير عن الذنوب.
في شكل أعمق، ليس الغنيّ بطل الرواية الأبرز في همّ الفقراء. الله في الواقع يحمل همّ الفقراء أوّلاً، إنّه الملجأ الحقيقي للفقراء والبؤساء، يؤاسي المحزون ويُنْهض الفقير. الله يستمع الى الفقراء ويشبعهم، يحكم لصالحهم، ويضعهم في المرتبة الاولى. وهو يُذِلُّ المتكبّرين.
في اختصار، تظهر خلاصة دقيقة ولكن واضحة في تعاليم العهد القديم. إنّ الثراء يمنحه الله، وهو تاليًا جيّد في ذاته، لكنه ينطوي على أخطار كبيرة، بخاصّة أنّ الأساس هو في مكان آخر، لا سيما في العالم الآخر، العالم الحقيقي الوحيد الثابت: من هنا يعني الاستخدام السليم للثروة، الحكمةَ التي لها وحدها قيمة أساسية، إضافة إلى أنّ أوّل واجب على الغني، هو مساعدة الفقير. إنّ هذا الواجب، هو أساس له، بل هو الوحيد الذي يطلب منه صراحةً، إضافة الى الحكمة التي يجب احترامها في تعامله مع ثروته. وهذه العلاقة بين الأغنياء والفقراء ليست مجرد أمر أخلاقي، لأنّ الله يُعنَى بها مباشرة.
الفصل الثاني
الإنقلاب مع العهدُ الجديد
التغيُّر الجذري في الإنجيل
لم يكن في استطاعة العهد الجديد أن يُبقى على مستوى الاقتصاد الصرف. في الحقيقة يطلب منّا يسوعُ تغيُّراً جذرياً في آفاقنا وأبعادنا، وهو يقودنا بعيداً جداً عن الواقع الاقتصادي الحالي. المهم أنه لا يطلبُ منا التخلي عن العقلانية الاقتصادية. ففي الواقع، ينتج التغيّر من وضع حقائق هذا العالم في منظورها الصحيح، مقارنة بحقائق العالم الآخر، الذي هو عالم المملكة التي ليست من هذا العالم، بل هو عالم الحياة الأبدية. ويكفي تفضيلُ هذا العالم الآخر لقلب وجهات النظر كلّها ما يقودنا إلى خلاص أبعد بكثير من تلك الحسابات.
ثروات هذا العالم الى زوال
يُشكّل التضارب بين القِيَمِ الدائمة والقيم الانتقالية،ّ الحجّة الرئيسة التي يستعملها يسوع كما ورد في الأناجيل، أقلّه في المرحلة الأولى من التعاليم. فحقائق هذا العالم جميعها إلى زوال، وهي رهنٌ لأخطار ماديّة لا تعدّ أو تُحصى (الحيوانات المفترسة، الأمراض والعواصف)، أو من مصدر بشري،(اللصوص، الحروب وغيرها). وعلاوة على هذا، حتى في أفضل الأحوال، يمكن لثرواتنا أن تدوم ولكن ليس نحن، لأننا نموت. لكن في المقابل، كلّ ما يمكن جمعه بهدف اكتساب العالم الآخر يحتفظ بقيمته إلى الأبد. وترتسم الخلاصة في قول يسوع: "لا تكنزوا لأنفسكمْ كنوزًا في الأرض، حيثُ يُفسِدُ السوسُ والصَّدأُ، وينقُبُ السارقونَ فيسرقون. بل اكنزوا لأنفسكم كنوزًا في السماء، حيثُ لا يُفسدُ السوسُ والعثُّ، ولا ينقُبُ السّارقون فيسرقوا. فحيثُ يكونُ كنزك يكونُ قلبك. (متى 6: 19 – 21)
وواضحٌ إذًا أن القيمةَ اللامتناهية، كونها أبدية، للاستثمار بهدف ربح العالم الآخر، تكون دائماً من دون منازع، أفضل من أموال هذا العالم. فأموالُ هذا العالم تشبه إقامتنا فيه، هي الى زوال. ولافتٌ جداً أن الإنجيل ذاته يستخدم وبإصرار هذه الحجة العقلانية الاقتصادية البحت، إمّا لتعليم من يؤمن فعلاً بهذا العالم الآخر، أو لدفع من ليس مقتنعًا بعد، الى ضرورة التفكير في الأمر. فإذا كان المنطق الاقتصادي يقتصر على هذا العالم فقط، فإنّه يتركنا في إحباط كبير. ففي نهاية المطاف نفقد ثمرة جهودنا كلّها، على الأقل بالموت. ما يقلّص بشدّة من وجهة نظر عقلانية، نتائج الجهود التي نبذلها في بناء الثروات.
"القيمة" الحقيقية في مكان آخر
ونلحظُ أيضاً، من زاوية أخرى، أن النصوص جميعَها تشدّد على هذا الضعف الأساس للاقتصاد البحت، الذي يَعني التفكير في الطريقة الأكثر عقلانية لإنتاج الأموال وتبادلها، ولكن من دون أيّ اعتبار للقيمة الجوهرية للأشياء، ما يحمل على الافتراض أن نظام التفضيلات الفردية في الواقع، يقتصر على هذا العالم. بتعبيرٍ آخر نفترض أننا نعطي النظامَ، قيم هذا العالم. ويُقال بعبارة أخرى عكسية: فكّروا بما يُمكن أن يكون ممتلكات حقيقية. لأن المفهوم، من وجهة نظر اقتصادية، لا يُمكن أن يكون إلا ما يؤمّن قيمة أبدية لا مثيل لها، وهذا لا يمكن تاليًا أن يكون في هذا العالم. ما يَعني أنّ نظامَ الأفضليات الذي يقتصر على اعتبارات هذا العالم فقط، ليس خاطئًا فحسب، بل غير عقلاني، لا سيما من الناحية الاقتصادية. فمن يعتمد على هذا العالم وحده معرّض لأن يُصاب سريعاً بخيبة، يتخيّل أنه يستثمر ويحقّق مكاسب، ولكن من دون تقدير كم أنّ وجوده معرّض للخطر. وفي هذا السياق، يقوم القديس يعقوب بقدح وذمّ من يقولون {"سنذهب اليوم أو غداً الى هذه المدينة أو تلك، فنقيم فيها سنةً نتاجر ونربح"، أنتم لا تعلمون ما تكون حياتكم غداً. فانّكم بُخارٌ يظهر قليلاً ثمّ يزول". هلاّ قلتم : "إن شاء الله، نعيش ونفعل هذا أو ذاك" (يعقوب 4: 13-15)}.
ونلحظُ أيضاً، من زاوية أخرى، أن النصوص جميعَها تشدّد على هذا الضعف الأساس للاقتصاد البحت، الذي يَعني التفكير في الطريقة الأكثر عقلانية لإنتاج الأموال وتبادلها، ولكن من دون أيّ اعتبار للقيمة الجوهرية للأشياء، ما يحمل على الافتراض أن نظام التفضيلات الفردية في الواقع، يقتصر على هذا العالم. بتعبيرٍ آخر نفترض أننا نعطي النظامَ، قيم هذا العالم. ويُقال بعبارة أخرى عكسية: فكّروا بما يُمكن أن يكون ممتلكات حقيقية. لأن المفهوم، من وجهة نظر اقتصادية، لا يُمكن أن يكون إلا ما يؤمّن قيمة أبدية لا مثيل لها، وهذا لا يمكن تاليًا أن يكون في هذا العالم. ما يَعني أنّ نظامَ الأفضليات الذي يقتصر على اعتبارات هذا العالم فقط، ليس خاطئًا فحسب، بل غير عقلاني، لا سيما من الناحية الاقتصادية. فمن يعتمد على هذا العالم وحده معرّض لأن يُصاب سريعاً بخيبة، يتخيّل أنه يستثمر ويحقّق مكاسب، ولكن من دون تقدير كم أنّ وجوده معرّض للخطر. وفي هذا السياق، يقوم القديس يعقوب بقدح وذمّ من يقولون {"سنذهب اليوم أو غداً الى هذه المدينة أو تلك، فنقيم فيها سنةً نتاجر ونربح"، أنتم لا تعلمون ما تكون حياتكم غداً. فانّكم بُخارٌ يظهر قليلاً ثمّ يزول". هلاّ قلتم : "إن شاء الله، نعيش ونفعل هذا أو ذاك" (يعقوب 4: 13-15)}.
الاستثمار في العالم الآخر
وإذا كان الاستثمار في العالم الآخر صالحًا وجيّدًا، فلأنه الاستثمار الوحيد الذي يمكن القيام به في شكل مستديم. يقول يسوع: "لا تخف أيّها القطيع الصغير، فقد حَسُنَ لدى أبيكم أن يُنعِم عليكم بالملكوت. بيعوا أموالكم وتصدّقوا بها واجعلوا لكم أكياساً لا تَبلى، وكنزاً في السموات لا يَنْفَد، حيث لا سارقَ يدنو ولا سوسَ يُفسد. فحيث يكون كنزُكُم يكون قلبكم".(لوقا 12: 32-34) فما يهمّ هو تحرير القلب من الجشع، فلو كان الإنسان يملك الكثير من الثروات فلا يمكنه أن يُحصي حياته من بينها. بتعبيرٍ مختلف، لا يمكن أن تشكّل الحياة، مقارنةً بتقدير جميع الممتلكات الأخرى، ملكيّةً في ذاتها. فالرجل الغنيّ الذي أخصبت أرضه، فبنى من حينه أهراءات أكبر، واعتقد أن في إمكانه أن يستريح بفضل هذا الجهد ويستمتع بوقته: "يا نفسيِ، لك أرزاق وافرة تكفيك مؤونة سنين كثيرة، فاستريحي وكلي واشربي وتنعّمي"، لكنّه لم يأخذ في الاعتبار هشاشة الحياة البشرية، لأنّ المسكين مات في الّليل، ولا ندري الى من ذهبت أملاكه. ونَعَته الله بالغبيّ. " فهكذا يكون مصير من يكنز لنفسه ولا يغتني عند الله". (لوقا 12: 15-21). ويُختصر المغزى من مثل يسوع: اجعلوا لكم كنوزاً نعم، ولكن في الله. وذلك مختلف جداً. وتبرز هنا شخصيّة مَثَل الكنز المخبّأ في الحقل، حيثُ يقضي القرار التحكيميّ ببيع كلّ شيء لشرائه، وهذا ما يتبرّر الى ما لا نهاية في حالة الملكوت الذي تفوق قيمته أيّ أملاك وأموال في هذا العالم.
وتقع المصيبة أكثر على من تقوم ثرواتهم على القلق، وكما يقول القديس يعقوب: "يا أيها الاغنياء، ابكوا وأَعولوا على ما ينزل بكم من الشقاء. ثروتكم فسدت وثيابكم أكلها العثّ. ذهبكم وفضّتكم صدئا، وسيشهد الصدأ عليكم ويأكل أجسادكم كأنّه نار. جمعتم كنوزاً في الأيام الاخيرة. ها إنّ الأجرة التي حرمتموها العَمَلة الذين حصدوا حقولكم قد ارتفع صياحها، وإنّ صراخ الحصّادين قد بلغ أذنيّ ربّ القوّات. عشتم على الأرض في التنعّم والترف وأشبعتم أهواءكم يوم التذبيح. حكمتم على البارّ فقتلتموه وهو لا يقاومكم". (يعقوب 5، 1-6). هذا ما يُعتبر الاستثمار السلبي حيث تنقلب ثروات هؤلاء الأغنياء عليهم وتقهرهم.
ويستخدمُ يسوعُ في استمرار مفردات تحملُ ازدواجية في الاستثمار: "اجعلوا لكم كنوزاً، نعم، ولكن على اعتبار الوسيلة العقلانية الوحيدة اقتصادياً لجمع الكنوز، هي في عالم آخر. الادخار وتكديس الأموال الحقيقي الوحيد، الذي لديه معنى عقلانيّ، هو في العالم الآخر، بغض النظر عن الموجبات الأخلاقية الحاسمة التي تفرضها السلطة، ولكن بعقلانية بحتة نوعًا ما مالية! لأنه بتحقيق الادخار، تُزالُ مسألة النُّدرة، ويصيرُ التكديس تاليًا لامتناهيًا: لا يُفقدُ شيءٌ، وتصبح الوفرة بلا حدود.
ما نحن عليه، وليس ما نملك
يكتمل هذا الواقع مع اعتبارين أساسيين آخرين. الأول أننا، لسنا ما نملك. وقد أُثبِتَ بالفعل واقعُ أننا في موتنا لن نأخذ معنا ممتلكاتنا المادية. في المقابل، نأخذ معنا الى العالم الآخر ما نحن عليه، وكذلك تجاربنا، وذكريات أفعالنا، وبخاصّة الطريقة التي طبعتنا وشكلتنا. هنا فقط تكمن الحقيقة الوحيدة الدائمة، التي يستثمر فيها حقّاً في هذا العالم. ولكن في الوقت ذاته إنه استثمارٌ لا نملكه بالمعنى الدقيق للكلمة، أو على الأقل لا يمكننا التصرّف به. وثمة مثال رائع على ذلك هو قصة الابن الضال: نعرف انه سأل والده مسبقاً الحصول على حصّته من الميراث، وهذا يعني الجزء المادي من هذا الميراث، الجزء الوحيد الذي يدرك وجوده في ذاك الوقت. بدّد هذا المال على الملذّات كافّةً. أفلس، وانتهى به الأمر لأنْ يعيش بائساً. وعاد في النهاية وبعد كلّ عنائه، الى أبيه ليجد القسم الآخر من الثروة: الانتماء الى العائلة، الجماعة البشرية، المُلك الروحيّ الذي لا يفنى، وبالطبع استقبله أبوه بذراعين مفتوحتين. (لوقا 15: 11-32)
الثروة في هذا العالم مثل فخّ الشيطان
والاعتبار الثاني، أن الشيطان هو أمير هذا العالم، يسعى تحديداً إلى إلهائنا وصرفنا عن الاستثمار في الحياة الأبدية، إذ يدفعنا الى كمين إغواءات الحياة المادية المباشرة والفورية، ما يعني أنّه يدفعنا عمداً إلى حسابات خاطئة، بتشويه منطقنا الاقتصادي. ففي إغراء يسوع، نلاحظ أنّ إبليس أراه جميع ممالك الأرض في لحظة من الزمن، وقال له: أوليك هذا السلطان كلّه ومجد الممالك، لأنّه سُلِّمَ إليّ وأنا أوليه لمن أشاء. فإن سجدتَ لي، يعود إليك ذلك كلّه. فأجابه يسوع: مكتوب للربّ إلهك تسجد، وإيّاه وحده تعبد. (لوقا :4 5-8). وبعبارة أخرى، تبقى وعود الشيطان على مستوى هذا العالم وحده، ويستند منطقه بالكامل على استبعادِ واقعٍ أكثر جوهرية بكثير، ألا وهو الله، أصل كلّ شيء ومصدره، والحياة الأبدية التي يقدّمها لنا.
الفصل الثالث
الـ "أغنيـاء"
اللّعنة التي تقع على الـ "الأغنياء"
في ضوء هذه الاعتبارات لا بد من تحليل اللعنة التي يحملها يسوع الى "الأغنياء". في نشيد مريم العذراء تكمنُ استمراريةٌ مع العهد القديم،حيثُ تُنشد: " إنّه شتّت المتكبّرين في قلوبهم، وحطّ الاقوياء عن العروش، ورفع الوضعاء. أشبع الجياع من الخيرات وصرفَ الأغنياء فارغين. (لوقا 1 : 51-53)
ونحن نعلم أساساً كلمة الله الرهيبة عندما يقول: ليس فقط يعسر على الغنيّ أن يدخل ملكوت السموات، بل أيسر على الجمل أن يعبرَ من ثقب الإبرة من أن يدخل الغنيّ ملكوت السموات. وحتى لو اتّفقنا على أنه لا ينبغي أن يؤخذ الأمر حرفياً ( إذ يقول البعض إن "ثقب الإبرة" هو ممرّ ضّيق للغاية في القدس)، تبقى الإدانة مفاجئة، ما جعل - في النص المذكور– التلاميذ محتارين، لأنهم تساءلوا من الذي يمكن انقاذه إذاً؟ ونلاحظ، علاوة على ذلك وضوحهم، لأنهم كانوا شخصياً فقراء بالمعنى المتداول للكلمة، ولكنهم كانوا يفهمون أن مصطلح "غنيّ" لا ينطبق فقط على الناس الذين هم حقاً أثرياء، بل يشمل أيَّ ملكيّة مرضية. ثم قال لهم يسوع: أمّا الناس فهذا شيء يعجزهم، وأمّا الله فإنّه على كلّ شيء قدير. (متى 19: 21-26) وهذا نصّ استفزازيّ بامتياز، ولكنّه منفتح.
التخلّي عن جميع الثروات
وثمة مسألة ذات صلة هي التخلّي الفعليّ عن ثروات هذا العالم. وفي نصّ معروف أيضاً، يتحدث يسوع الى شاب غنيّ، بعد أن سأله عن احترامه للوصايا، الصحيحة ظاهرياً، فسّر قائلاً إنّه ما أن تمّ احترام الوصايا والقانون، وإذا أردت أن تكون كاملاً، فاذهب وبِع أموالك واعطها للفقراء، فيكون لك كنز في السماء. ولمّا سمع الشاب هذا الكلام، انصرف حزيناً لانّه كان ذا مالٍ كثير. (متى 19: 21-22 ، لوقا: 18-30) هنا أيضًا يبدو الخيار جذرياً، وكما أكّده نصّ آخر: "من لم يكن معي كان عليّ، ومن لم يجمع معي كان مبدّداً". (متى١٢:٣٠)
لكن يوجدُ في الوقت ذاته أغنياء بالمعنى الواقعي للمصطلح، لا يعمدون الى التخلّي الجذري عن ثرواتهم كلّها، أمثال نيقوديموس ويوسف الرامي، كان لديهما مركز اجتماعي مرموق ولم يتخليا عن أي من ممتلكاتهما، ما يسمح لهما أيضًا بأن يلعبا دوراً ذُكِر تاريخياً، لم يكن ممكناً لولا آلام يسوع ودفنه. حتى زكّّا، وهو غنيّ ورئيس العشّارين، ليس لثروته مصدر ذو قيمة معتبرة، يأخذ المال ويتخلّى عن نصفه ويُعيد المبالغ المسروقة أربعة أضعاف: إنه لأمر جيّد، ولكن لا يؤدّي الى التخلّي التامّ عن الأموال. ومع ذلك يخلّصُ الرجلُ نفسه بهذه الطريقة، فيسوع يقول بوضوح: "اليوم حصل الخلاص لهذا البيت ... لأن ابن الانسان جاء ليبحث عن الهالك فيخلّصه". (لوقا 19 ، 2-10) ويجب علينا قياس الفرق بين الحالتين، زكّا والشاب الغنيّ، كان زكا رجلاً يعيش حقّاً في الخطيئة العامة، بما فيها نشاطه المالي، وأعلن اهتداءه بإعادة ما سَرَق وتعويض من ظلم، وليس أكثر من ذلك. هنا يمكن للمرء أن يتصور أنه في نهاية المطاف يستخدم مركزه الاجتماعي الذي لا يزال يملكه ليقوم بمزيد من أفعال الخير. في المقابل، فإن الشاب الغني ليس لصّاً، وليس هناك من عتاب أو لوم على وضعه، والسؤال الذي يطرح ذاته عليه هو كيف له أن يتمكن من التوصل إلى مرحلة أعلى، إلى الكمال أي مرحلة القداسة. وهذا يفترض، في حالته، التخلي عن ثروات شريفة بالتأكيد، ولكنه متعلّق بها في شكل مفرط. بتعبيرٍ جديد، يجب علينا أن نميّز في هذه القصّة مستويين من الطلب: مستوى يعود الى شروط الحياة الأبدية، الذي كان الشاب ظاهرياً يوفيها، ومستوىٍ يستهدف الكمال، ما قد يعني التخلي عن الممتلكات كلّها، ما يؤكد وجود، ليس فقط أنواع من الدعوات، ولكن أيضا مستويات عدّة في النداء. ونلاحظ أيضا أن الرسل الذين تخلّوا عن كلّ شيء ليتبعوا المسيح يُكافأون، ليس فقط بالخلاص العاديّ، بل سيشاركون أيضًا في سلطان المسيح وعهده.
اللعنة تقع على "الأغنياء" الذين يعرّفون عن أنفسهم أغنياء فقط
ولذلك يبدو أن وضعاً ما، وضع "الغنيّ"، يظهر من جهة غير متوافق عملياً مع الخلاص، وأن هذا يشمل قسماً أكبر من هؤلاء الأغنياء الحقيقيين بالمعنى المتعارف عليه، ما يعني أنه في حالاتٍ، يكونُ التخلي الكامل عن الثروة إلزاميًّا، وبخاصّةٍ لاستهداف الكمال. ولكن من ناحية أخرى، يحافظ البعض على ثروات ملموسة، مع كونهم تلاميذ للمسيح، وقد تمّ خلاصهم. إضافةً إلى ذلك، نجدُ في كلام يسوع تأييداً نسبياً لوقائع الحياة الاقتصادية، التجارية حتّى والمالية. فالتحليل المنطقي الذي يقودُ أوّلاً الى التوجّه نحو حقائق الملكوت وتاليًا إلى تكديس الثروات الروحية في العالم الآخر، يحترم في شكل ما المنطق الاقتصادي، ولكن عن طريق إدخال عامل جديد تماماً، وهو تحديداً ملكوت السموات. إنّ اللعنة ضدّ الأغنياء تستهدف فئة معيّنة، فئة الذين يعرّفون عن أنفسهم كأغنياء فقط، وتتكوّن ثروتهم الوحيدة ( ولو كانت قيمتها المطلقة ضعيفة)، واكتنازهم الوحيد، من هذا العالم. هذا هو بالضبط ما يعنيه قول يسوعُ المعروف: الويل لكم أيها الاغنياء، فقد نلتم عزاءكم. (لوقا ٦/٢٤) أي أنّكم لم تسعوا إلا الى الملذات في هذا العالم، هكذا فقط استخدمتم ما أُعطي لكم.
لا يستطيع المرء أن يخدم سيدين: الله والمال
وتكون المسألة أكثر وضوحاً عندما نأخذ في الاعتبار نصوصاً أخرى. إنها في البداية المقولة الحكيمة والقوية، التي وفقها "ما من أحدٍ يستطيع أن يعمل لسيّدين. لأنه إمّا أن يبغض أحدهما ويحبّ الآخر، وإما أن يلزم أحدهما ويزدري الآخر" (متى ٦/ ١٤). "إنّ سبب هذه الاستحالة عميق، لأنّ في القلب البشريّ لا مكان لكليهما. حكمة مهمّة، لا يوجد مثيلٌ لها في مجالات أخرى للطموح البشريّ، السلطة أو المتعة على سبيل المثال: كما لو أنّ المال يلعب دوراً شاملاً ليُبعدنا ويضلّلنا عن الطريق الصحيح. أما التوافق بين الأمثلة الاقتصادية ومفردات الاقتصاد في الأناجيل، فلأنّ مسألة الثراء والممتلكلت المادية تعنينا جميعاً. ولا ينحصرُ الموضوع في مسألة تقسيم الثروة المحض فقط، وان كان المال هو المشكلة، بل يتجلّى في الانبهار الذي يسبّبه المال، ما يؤدي إلى اتّخاذه سيّداً". المشكلة إذًا في هذه العلاقة غير الطبيعية مع المال. ونعرف أنّه في مَثَل الزارع، "ما زُرع في الشوك فهو الذي يسمع الكلمة، ويكون له من همّ الحياة الدنيا وفتنة الغنى ما يخنق الكلمة فلا تخرج ثمراً". (متى 13/ 22) "يجب أن يأخذ الحساب الاقتصادي في الاعتبار السلطة الانجذابية غير الطبيعية للثراء، فيُنظَرَ إليها فقط من وجهة نظر هذا العالم، ما يعني أنّ لها القدرة على أن نضيّع أنفسنا فيها، وهو أمر ينحصر جذرياً في العالم الآخر". يقول بولس في رسالته الأولى إلى طيموتاوس: "إننا لم نأتِ العالم ومعنا شيء، ولا نستطيع أن نخرج منه ومعنا شيء. فاذا كان عندنا قوت وكسوة فعلينا أن نقنع بهما. أما الذين يطلبون الغنى فيقعون في التجربة والفخّ وفي كثير من الشهوات العميّة المشؤومة التي تغرق الناس في الدمار والهلاك. لأنّ حبّ المال أصل كلّ شرّ. وقد استسلم إليه بعض الناس فضلّوا عن الايمان وأصابوا أنفسهم بأوجاع كثيرة". (طيموتاوس الأولى 6: 7- 10) "ويمكنُ أن نرى كيفَ يَكمُن الشرُ في هذه الحركة الداخلية التي هي الجشع والرغبة في الثراء، التي تقودنا في الاتجاه الخاطئ، إتّجاه المغريات الحمقاء في هذا العالم، ما يُشكّلُ مصادر خيبة الأمل والآلام".
طوبى للفقراء في الروح
تقول عِظاتُ الجبل في إنجيلِ متى: "طوبى لفقراء الروح فإنّ لهم ملكوت السموات". (متى5/3) بينما ينقلُ لوقا قولَ يسوع فقط: "طوبى لكم أيّها الفقراء، فإنّ لكم ملكوت الله (لوقا 6/ 20)، طوبى للمحزونين فانهم يعزّون (متى 5/ 5)، طوبى للمضطهدين على البرّ، فإنّ لهم ملكوت السموات.(متى 5/10) إذن يجب أوّلاً أن نكون فقراء في الروح، ولكن إذا كنا كذلك، ينطبق بالتالي المنطق الاقتصادي أعلاه: أي إنّنا "نمتلك" شيئاً ما ولكن في العالم الآخر. وإذا قارنّا هاتين النقطتين، نفهم أن الفقراء في الروح هم الذين أدركوا أنّ المال والملك الحقيقيّن الوحيدين هما في العالم الآخر، والأغنياء هم الذين لم يفهموا حقيقة الموضوع. "فالأغنياء، عموماً، أخذوا أجرهم في هذا العالم، ما يعني أنّهم تابعوا هدفاً في هذا العالم، ونجحوا، لكنّهم في نجاحهم وتحقيقهم للثروة ما يدفعهم مباشرةً أو في طريقةٍ وسبلٍ غير مباشرة الى قمع الآخرين أو التسبّب في إيلامهم. لذا يصبح السلوك غير منطقي من الناحية الاقتصادية، وبخاصةٍ إذا أُدخلتْ نظرية الملكوت. ويؤدي قمعُ الآخرين وسلبهم أموالهم إلى تحقيق هدف أقل جاذبية من الهدف الآخر، أي ربح الملكوت السماوي، ومع خسارة هذا الملكوت، نعرفُ أن الأمرين لا يجتمعان.
إخضاع منطق هذا العالم إلى منطق العالم الآخر
يمكننا أن نجد في هذا الإطار الرجلَ غير الشريف المؤتمن على أموال سيّده فيختلسها، ما يدفع سيّدَه إلى تهديده، ليُتيحَ أمامه الفرصة لتحضير حياته المستقبلية. ويمكن اعتبار الترجمة الروحية لهذا المثل في قولِ يسوع: إفعلوا مثله، "لأنه كان أكثر فطنةٍ من أبناء النور"، اختلسوا ثروات هذا العالم للاستثمار في العالم الآخر. ويُضيفُ يسوع: "وأنا أقولُ لكم، اتّخذوا لكم أصدقاءَ بالمال الحرام، حتّى إذا فُقدَ، قبلوكم في المساكن الأبدية". والترجمة اللفظية ليست المساكن، بل "المظال الأبدية". ولا ترد هذه العبارة في غير هذا النص، وهي تدلُّ على "مكان الخلاص". وهي دعوةٌ إلى كنزِ الكنوزِ في السماء.
يمكننا أن نجد في هذا الإطار الرجلَ غير الشريف المؤتمن على أموال سيّده فيختلسها، ما يدفع سيّدَه إلى تهديده، ليُتيحَ أمامه الفرصة لتحضير حياته المستقبلية. ويمكن اعتبار الترجمة الروحية لهذا المثل في قولِ يسوع: إفعلوا مثله، "لأنه كان أكثر فطنةٍ من أبناء النور"، اختلسوا ثروات هذا العالم للاستثمار في العالم الآخر. ويُضيفُ يسوع: "وأنا أقولُ لكم، اتّخذوا لكم أصدقاءَ بالمال الحرام، حتّى إذا فُقدَ، قبلوكم في المساكن الأبدية". والترجمة اللفظية ليست المساكن، بل "المظال الأبدية". ولا ترد هذه العبارة في غير هذا النص، وهي تدلُّ على "مكان الخلاص". وهي دعوةٌ إلى كنزِ الكنوزِ في السماء.
"يمكنُ إذاً استخدام ثروات هذا العالم للفوز بالعالم الآخر، ولكن بالخروج من ماهيّة هذه الأموال كما تُفهم عفوياً في هذا العالم. ويبدو أنّ الغاية هي المفتاح، كما وردَ في النص ذاته: "من كان أميناً على القليل، كان أميناً على الكثير أيضاً. ومن كان خائناً في القليل كان خائناً في الكثير أيضاً. فإذا لم تكونوا أمناء على المال الحرام، فعلى الخير الحقِّ مَنْ يأتمنُكم؟ واذا لم تكونوا أمناء على ما ليس لكم، فمن يعطيكم ما لكم"؟ ومرةً أخرى، يقولُ يسوع: "ما من خادم يستطيع أن يعمل لسيّدين، فأنتم لا تستطيعون أن تعملوا لله والمال" (لوقا ١٦: ۹-١٣). فيسوعُ يميّز في وضوح بين احترام منطق هذا العالم في مجاله من جهة، حيث ينبغي التعامل مع أشياء هذا العالم في الظروف التي تكون فيها وحدها المعنيّة، ومنطق العالم الآخر من جهة أخرى عندما يجب أن نعلم من نخدم، ما يعني أهدافنا وقيمنا الحقيقية، ومبتغانا الواقعيّ. فلا يمكن على وجه الخصوص مثلاً أن نسرق المال لفعل الخير، ولكن نستخدم فقط ما نملكه شرعياًً، لخدمة الله وليس المال.
الفصلُ الرابع
الاقتصاد والعطاء
أعط الفقراء، وهذا يعني من دون حساب لمقابل في هذا العالم، ولكن في انتظار هبة الله
يدعو يسوع إلى فعل الخير ومحبّة الله، بطريقة لا تكترثُ، وفق حسابات هذا العالم، بحجم العطاء للفقراء. ما يؤكده ويُفسّرُ في نصٍّ آخر من ناحية التوسّع الاقتصادي أنه يستحسن العطاء للفقير وليس لأحد آخر. ففي الواقع، لا يمكن للفقير أن يردّ ما أُعطيَ من مالٍ، مثلما قد يفعل الغنيّ، ما يجعل للمؤمنين - في هذا العالم - "دين" في العالم الآخر. "لا تدعُ أصدقاءك ولا إخوتك ولا أقرباءك ولا الجيران الأغنياء، لئلا يدعوك هم أيضاً فتنال المكافأة على صنيعك. ولكن إذا أقمتَ مأدبة فادعُ الفقراء والكسحان والعرجان والعميان. فطوبى لك إذ ذاك لانهم ليس في إمكانهم أن يكافئوك فتكافأ في قيامة الابرار". (لوقا 14: 12- 14)
"بعيداً عن حساباتِ هذا العالم، يدعو يسوع المؤمنين إلى الإيمان بأن الله يهب نفسه إلينا، وبمعنى آخر، ليس عملُ الخيرِ أو الصدَقَة عمليّات حسابية تُضاف إلى حسابات هذا العالم. فالمؤمنون مدعوون إلى تخطي كل الحسابات، وفي انفتاحهم على فهم هذه الهبة اللامتناهية وهي حياة الله، هم مدعوّون إلى المشاركة في هذه الحياة، من خلال إعطائهم من دون حساب. ويتعلّم المؤمنون عندما يجدون في أنفسهم وفي الآخرين، الذين هم في حاجة، أنه لا يمكن العيش من دون هذا الانفتاح. انفتاحٌ يُعطي من دون حساب مقارنة مع حسابات هذا العالم، وهو يمتدّ ويتجاوزها. إنّ الحساب بمعنى الثواب هو تحضير إلى تجلٍّ يقودنا إلى التغلب عليه في سرعة. والأسلوب الأفضل هو إعطاء من لا يمكنه أن يردّ العطاء وفقاً لمعنى الحسابات المعنيّة".
سبق ليوحنا المعمدان أن دعا: "من له ثوبان، فليعط واحداً لمن ليس له"، في الواقع إن إعطاء الفقير هو مثل إعطاء الله، وحتى كأس ماءٍ يعط إلى فقير "تكون له مكافأته". (متى 10: 40-42) فمن يُعطي فقيراً، يُعطي من دون انتظار أجرٍ أو مقابل في هذا العالم، ما يعني أنه لم يُعطِ من دون عقلانيّة، ولكن بروحيّة متّجهة نحو العالم الآخر، بروحيّة من الاستسلام إلى هبة الله اللامتناهية؟ وعلى العكس، من يكرم الأغنياء يقوم بحساب خاطئ كما يذكر يعقوب في رسالته: "اسمعوا يا أخوتي الأحباء: أليس الله اختار الفقراء في نظر الناس فجعلهم أغنياء بالإيمان وورثة للملكوت الذي وعدَ به من يحبّونه؟ وأنتم أهنتم الفقير. أليس الأغنياءُ همُ الذين يظلمونكم ويسوقونكم إلى المحاكم". (2: 5-7) فلا يفصلُ يعقوب بين الأغنياء في وجهٍ عام والأغنياء الذين لهم مكانةٌ خاصة في المجامع المسيحية، فيسوق في شأن هذه الفئة آراء مفرغة في قالبٍ واحد. (الكتاب المقدس العهد الجديد صفحة 728)
وفي مشهدية يوم الدينونة، يُثيرُ يسوعُ نقطة أساسية هي المساعدة المقدمة إلى المحتاجين: "كنتُ جائعاً ولم تعطوني شيئا آكله"، إلخ. وفقاً لهذه الرواية، أجابوه: "متى كنتَ جائعاً أيّها الرب ولم نعطِك ما تأكله؟"، ويقولُ للأبرار: "ما قمتم به لأصغر الناس، فعلتموه معي". أوتعني عبارة "أصغر الناس" من لا يمكنه أن يردَّ ما أُعطي له. إذن من يعطي يسوع هو من يعطي في شكلٍ لا يمكن استرداد عطاءه في هذا العالم، بل توجّهه فضيلةٌ إلهية بامتياز، هي الإحسان (المحبة)، التي تأتي من الله وتذهب إليه، ما يعني تاليًا محبة أعدائنا أي من لا يُحبُّنا "فإن أحببتم من يحبّكم، فأيّ أجرٍ لكم؟ أوليس العشارون يفعلون ذلك"؟ (متى 5/ 46). فان أحببتم من يحبّكم فأيّ فضل لكم؟ لأنّ الخاطئين أنفسهم يحبّون من يحبّهم؟ وإن أحسنتم الى من يحسن إليكم، فأيّ فضل لكم؟ لأن الخاطئين أنفسهم يفعلون ذلك. وأن أقرضتم من ترجون أن تستوفوا منه، فأيّ فضل لكم؟ فهناك خاطئون يقرضون خاطئين ليستوفوا مثل قروضهم. ولكن على مثال الله أحبّوا أعداءكم، وأحسنوا وأقرضوا غير راجين عوضاً في هذا العالم، فيكون أجركم عظيماً في العالم الآخر. (لوقا 6: 32-35) ما يعني أنّه لا يجب حتى مقاومة الشرير، ومن أراد أن يحاكمك ليأخذ قميصك، فاترك له رداءك أيضاً، ومن سألك فاعطه. (متى 5: 39-42)
ويُثبّت يسوع أهميّةَ العطاء في المثلِ الصارخ والرهيب "لعازر والرجل الغنيّ السيّء". كان هذا الرجل الغنيّ يتنعّم كل يوم تنعّماً فاخراً، وكان رجل فقير اسمه لعازر ملقىً عند بابه غطّت القروح جسمه، وكان يشتهي أن يشبع من فتات مائدة الغنيّ. وهنا تواردٌ مع ما قالته المرأةُ الكنعانية في تواضعٍ ليسوع بعد أن طلبت مساعدته في شفاء ابنتها من شيطانٍ "يتخبَّطها تخبّطًا شديدًا": فأجابته: "نعم يا رب! فصغارُ الكلاب ذاتها تأكل من الفتات الذي يتساقط عن موائد أصحابها" (متى 15/27) بعد قوله لها: "لا يُحسنُ أن يؤخذ خبزُ البنين فيُلقى إلى صغار الكلاب". (متى 15/26) وتوفّي الغنيُّ ولعازر كلاهما، فذهب الأخير إلى السماء، والآخر إلى الجحيم. وقال ابراهيم للغنيّ: "يا بني، تذكّر أنّك نلت خيراتك في حياتك ونال لعازر البلايا. أما اليوم فهو ههنا يُعزّى وأنت تعذّب". (لوقا 16: 19-31) وهنا تبرز أيضًا العلاقة بين مصطلحي "نحصد ما نزرع". يحصل لعازر في العالم الآخر على ما لم يحصل عليه في هذا العالم، ويتعذّب الغني، ليس لأنه يجب أن يتعذب في وقت أو في آخر، وإن لم يتعذب هنا، عليه أن يتعذب في العالم الآخر، ولكن لأنه لم يستعمل ثرواته في هذا العالم بهدف تعزية الآخر، وبالتالي العطاء. وبمعنى آخر، لأنه لم يستثمر أمواله كما يجب. فالثروات التي حصل عليها وأمّنت له الوقت الطيب، تصنّف على أنها "أشياء جيدة" أو "خيرات"، حصل الغني عليها له وليفعل الخير على السواء، ويُعطيها إلى مستثمرٍ. لكنّه فضّل الاحتفاظ بكلّ شيء لنفسه.هنا خطأه.
تُظهِر الحسابات... أنه يجب العطاء من دون حساب
وليُعطيَ سمعانَ الفريسي مثالاً عمّا هو العطاء والمحبة، قارن يسوعُ تصرّف الخاطئة التي أغدقت عليه العطورَ وغسلت رجليه، مع تصرف سمعان واستقباله المتحفّظ، وتظهر من جديد المفردات الاقتصاديّة. فهنا مقارنة مدينين تَتمُّ إعادة ديونهم. وواضح أنّ من كان يدين بأكثر لدائنه، حصل على الإعفاء الأكبر، هو الذي يملك حبّاً أكبر تجاه الدائن.
من هنا الخلاص للخاطئة: " إنّ خطاياها الكثيرة غفرت لها، لأنها أظهرت حبّاً كثيراً. وأما الذي يغفر له القليل، فإنّه يظهر حبّاً قليلاً " (لوقا 7: 39-50). يوجد إذًا ترابط بين علاقة المحبة والعطاء، وفي الحالين: "إن أعطيتُ، أحبَّني مديني أوبخاصةٍ الله، وإن أحببتُ، أُعطي. وبالطبع يقاس العطاء بالجهد المبذول". من هنا إعجاب يسوع بالأرملة الفقيرة التي وضعت فلسين في خزانة الهيكل. يقول لنا: إنّ هذه الأرملة الفقيرة أعطت أكثر منهم جميعاً، لأنّ هؤلاء كلّهم ألقوا في الهبات من الفاضل عن حاجتهم، أمّا هي فانّها ألقت ما تملك من حاجة معيشتها (لوقا 21: 1-4). يستخدمُ يسوعُ هنا المقياس فيقولُ في وضوح: إنها أعطت أكثر من كل الآخرين، فالعطاء تاليًا يقاس، ليس بالقيمة المطلقة، ولكن بالنسبيّة، وفقاً للجهد المبذول. إذًا ليس المبلغُ في ذاته ما يقيسُ الجدارة في شكل أو آخر، ولكن إمكانات العاطي أو الواهب. فالأموال موجودة لنستعملها، ما يعني لنعطيها، بعلاقة مباشرة مع العطاء والهبة. فإذا استعمِلتْ الأموال وأُعطيتْ بسخاءٍ وكرمٍ تكونُ جيّدة، وسيئة إذا لم تُعطَ.
في النهاية، "أَعطوا تُعطَوا: ستُعطَون في أحضانكم كيلاً حَسَنًا مَرْكومًا مُهَزْهَزًا طافحًا، لأنّه يُكال لكم بما تكيلون" (لوقا 6: 37-38). وبالروحيّة ذاتها، تهدفُ التوصيات جميعُها إلى الإعفاء من الديون المادية والمعنويّة على السواء، بدءًا من الصلاة الربيّة "الأبانا" حيثُ تتحدّث في نصوصٍ، عن إعفاء من الديون، حتى التي تبدو بطريقة ما مشروعة، وليس فقط عن مغفرة الخطايا. ولكن إذا كان العطاءُ نسبيًا، فتوجد مصلحة في إعطاء أكبر حصةٍ ممكنة. "يوجد في الوقتِ ذاته حسابٌ ويوجد تفتيتٌ للحساب: في النهاية يُظهر الحساب أنّه يجب العطاء من دون حدود..."
بالطبع هذا لا يعني أن الآب لا يعطي إلا للذي "استثمر" في العطاء. على العكس، فهو أيضاً يُعطي من دون حساب لمن يطلب: إسألوا تعطوا، أطلبوا تجدوا، إقرعوا يُفتح لكم لأن من يسألُ ينال، ومن يطلبُ يجدُ، ومن يقرعُ يُفتح له. فالأب الذي يطلب منه ابنه سمكة، لن يعطيه بدل السمكة حيّة، أو بدلَ البيضة عقربًا (يذكرُ متّى بدل الرغيف حجرًا 7/9)، "فإذا كنتم أنتم الأشرار تعرفون أن تعطوا العطايا الصالحة لأبنائكم، فما أولى أباكم السماويّ بأن يهب الروح القدس للذين يسألونه" (لوقا 11: 9-13). "هذه العلاقة الإيجابية التي، وإن كنّا سيّئين، نعرفُ كيف نستخدمها مع أقربائنا، يستخدمها الله معنا جميعاً. إن سألناه، نحظَ بفيضِ عطائه، روحه بل هو ذاته. فالعطاء غير المحدود الذي يطلبه الآبُ السماوي منا، إنما يعودُ إلى التشبّه به. لكن يُلاحظُ أن هذا البادرة العظيمةُ، تُقارنُ بتلك التي يقوم بها السيئ حتى لأقربائه. نجد دائماً هذه الفكرة بأن تحليلاتنا في الحياة الدنيوية ليست مستبدلة بمنطق آخر، ولكنها قياسًا هي المنطق العقلانيّ ذاته".
العطاء أوّلاً لله وبمحبّة
ويلاحظ أيضًا أن الهمّ المباشر للفقراء لا يصبح حصريًا على الإطلاق. فعندما أفاضت امرأة تائبة قارورة طيبٍ غالي الثمن على قدميّ يسوع، انتقد التلاميذ قائلين: لِمَ هذا الإسراف؟ فكان يمكن أن يباع غالياً، فيعطى ثمنه إلى الفقراء. شعر يسوع بأمرهم فقال لهم: لماذا تزعجون هذه المرأة؟ فقد عملت لي عملاً صالحاً. أمّا الفقراء فهم عندكم دائماً أبداً، وأما أنا فلست عندكم دائماً أبداً. فما يبدو غريباً، كونُ يسوع غير موجودٍ هنا إلاّ لوقت محدود، لا يبرّر تبديد المال عليه في شكل عطور ثمينة. "في الواقع أنفقت التائبة بسخاء من دون تفكير، بدافع المحبة ليسوع المجسّد في حياته الدنيوية. فطريقةُ التعبير عن محبّتها القويّة، وهي طريقة يريدها الله طبعاً، دفعتها لتُطيّبَ يسوعَ دام هو هنا، مستجيباً لمتطلّبات هذا الوجود الدنيويّ". إضافة الى أنّ التطييبَ بالعطور إعلان عن دنوِّ موته، ففي أيّامه كانوا يدهنون الميت بالعطور والطيب. بمعنى آخر، باتَ عملُ المرأة مجانيًّا وطقسيًّا دينيًّا في الوقت ذاته، وكان دفنُ الموتى يُعتبَرُ من أعمال الرحمة. وهو عملٌ يحظى بتقدير كبير، قالَ عنه يسوع: " الحقَّ أقولُ لكم: حيثُما تُعلَنُ هذه البشارة في العالم كلّه، يُحدَّث بما صنعتْ إحياءً لذكرها". (متى 26: 7-13)
"تجدرُ الإشارة إلى أن إنجيلَ يوحنا يُخبرُ بأن مريم، أخت مرتا، هي التي حصلت على الجزء الأفضل، في حين أنّ يهوذا هو الذي أبدى تلك الملاحظة، وهو كان سارقاً وصندوق الدراهم عنده، فيختلسُ ما يُلقى فيه. (يوحنا 12: 1-8). إنّه الرجل الذي لا يفكّر إلا من وجهات نظر هذا العالم، ويقوّم ما يعطى الى الله. تجدر الإشارة إلى أن يوحنا يحكي في الفقرة التالية كيف اتّفق يهوذا مع رؤساء الكهنة لخيانة يسوع. فالرجلُ الذي يحسب بكم يسلّم يسوع، ينفطر قلبه عندما يرى كم يُنفق من المال عليه، وما إعلانُه الاهتمام بالفقراءُ سوى ذريعةً ليحصلَ على المال في صندوقه. المال اختصاصه، ولكن على خلاف متّى أو زكّا، ظلّ متعلّقاً به بحسب مفهوم هذا العالم، ما يعنى أنّه استمرّ في التحليل وفقاً لهذا المعنى، من دون إدخال المقياس الأساس ألا وهو حبُّ الله اللامتناهي. فهاجسه هذا الحساب الاقتصاديّ، وهو غير قادرٍ على فهم القيمة الحقيقية للأشياء، لذا يُخطىءُ تاليًا في شكل كبير بهذا الحساب".
وتُُفيدُ الرواية الإنجيلية هنا بأنّ بعض الأمور الجوهرية، بما فيها ما يتعلّقُ بالله، لها منطقيًا تفضيلٌ على الفقراء، وتؤكد أن ما هو جيد هو الإنفاق بهدف العالم الآخر، وتاليًا من أجل الفقراء عموماً، أولئك الذين أخرجوا من عالم المال والجشع لأنهم مستبعَدون من شبكة تبادلات الاقتصاد المالي، وليس في قدرة هذا العالم إعادة الإعطاء إلى الفقراء لأنه إعطاء لله. وتوردُ الأناجيلُ أيضًا تقديم الهبات إلى الهيكل بحسب الطقوس اليهودية، لم يُنتَقَد أبداً. فالأرملة الفقيرة تأخذ من حاجتها الضرورية لتُعطي، ليس إلى من هو أفقر منها، بل إلى الهيكل، اي الله. (لوقا 21: 1-4) ، ولاقى عطاؤها هذا استحسان يسوع بقوّة".
ومهما تكنْ البادرة، فضروري أن تتمّ بهدف العالم الآخر، ما يعني محبة الله، من دون اكتراث لإرضاءات هذا العالم. فمَنْ يُعطِ الله بروح الغرور والتكبر والطمع، يجد جزاه في هذا العالم، ولا يُشكّل عطاؤه تاليًا "استثماراً" للعالم الآخر، فالله والمال سيّدان لا يلتقيان. فمَنْ يُعطي الهيكل، ويجد في عطائه إرضاءً لغروره، لا يُرضي كلاهما، ولا يفوزُ إلا بنصيبٍ في هذا العالم. فالسلوك الوحيد "الرابح" يكمن في عدم السعي إلا إلى العالم الآخر، مهما كانت البادرة. أو إذا كان العطاءُ لا يهدفُ إلى الحصول على مكافأة في هذا العالم، مثل العطاء إلى الفقراء، فيجبُ أيضاً ألاّ تكونُ غايةُ العطاء الظهور أو إرضاء غرور الذات. "أمّا أنتَ، فإذا تصدّقتَ، فلا تعلم شِمالُك ما تفعلُ يمينُك، لتكونَ صدقتُك في الخفية، وأبوك الذي يرى في الخُفية يجازيك" (متى 6: 3-4). وبالمثل للصلاة : و"إذا صلّيتم، فلا تكونوا كالمرائين، فإنهم يحبّون الصلاة قائمين في المجامع وملتقى الشوارع، ليراهم الناس. الحقّ أقول لكم إنّهم أخذوا أجرهم (متى 6/ 5)، وإذا صمتم فلا تعبسوا كالمرائين، فانّهم يكلّحون وجوههم ليظهروا للناس أنهم صائمون (متى 6: 16). ولكن إذا كان كل شيء يتم في الخفاء، ما يعني، من خلال التنظيم لتجنب أي مكافأة في هذا العالم، فعندئذ فقط يجازينا الله.
ليس لثروة هذا العالم معنى إلاّ بالنسبة إلى اللعالم الآخر
ويلاحظ أيضًا أن الهمّ المباشر للفقراء لا يصبح حصريًا على الإطلاق. فعندما أفاضت امرأة تائبة قارورة طيبٍ غالي الثمن على قدميّ يسوع، انتقد التلاميذ قائلين: لِمَ هذا الإسراف؟ فكان يمكن أن يباع غالياً، فيعطى ثمنه إلى الفقراء. شعر يسوع بأمرهم فقال لهم: لماذا تزعجون هذه المرأة؟ فقد عملت لي عملاً صالحاً. أمّا الفقراء فهم عندكم دائماً أبداً، وأما أنا فلست عندكم دائماً أبداً. فما يبدو غريباً، كونُ يسوع غير موجودٍ هنا إلاّ لوقت محدود، لا يبرّر تبديد المال عليه في شكل عطور ثمينة. "في الواقع أنفقت التائبة بسخاء من دون تفكير، بدافع المحبة ليسوع المجسّد في حياته الدنيوية. فطريقةُ التعبير عن محبّتها القويّة، وهي طريقة يريدها الله طبعاً، دفعتها لتُطيّبَ يسوعَ دام هو هنا، مستجيباً لمتطلّبات هذا الوجود الدنيويّ". إضافة الى أنّ التطييبَ بالعطور إعلان عن دنوِّ موته، ففي أيّامه كانوا يدهنون الميت بالعطور والطيب. بمعنى آخر، باتَ عملُ المرأة مجانيًّا وطقسيًّا دينيًّا في الوقت ذاته، وكان دفنُ الموتى يُعتبَرُ من أعمال الرحمة. وهو عملٌ يحظى بتقدير كبير، قالَ عنه يسوع: " الحقَّ أقولُ لكم: حيثُما تُعلَنُ هذه البشارة في العالم كلّه، يُحدَّث بما صنعتْ إحياءً لذكرها". (متى 26: 7-13)
"تجدرُ الإشارة إلى أن إنجيلَ يوحنا يُخبرُ بأن مريم، أخت مرتا، هي التي حصلت على الجزء الأفضل، في حين أنّ يهوذا هو الذي أبدى تلك الملاحظة، وهو كان سارقاً وصندوق الدراهم عنده، فيختلسُ ما يُلقى فيه. (يوحنا 12: 1-8). إنّه الرجل الذي لا يفكّر إلا من وجهات نظر هذا العالم، ويقوّم ما يعطى الى الله. تجدر الإشارة إلى أن يوحنا يحكي في الفقرة التالية كيف اتّفق يهوذا مع رؤساء الكهنة لخيانة يسوع. فالرجلُ الذي يحسب بكم يسلّم يسوع، ينفطر قلبه عندما يرى كم يُنفق من المال عليه، وما إعلانُه الاهتمام بالفقراءُ سوى ذريعةً ليحصلَ على المال في صندوقه. المال اختصاصه، ولكن على خلاف متّى أو زكّا، ظلّ متعلّقاً به بحسب مفهوم هذا العالم، ما يعنى أنّه استمرّ في التحليل وفقاً لهذا المعنى، من دون إدخال المقياس الأساس ألا وهو حبُّ الله اللامتناهي. فهاجسه هذا الحساب الاقتصاديّ، وهو غير قادرٍ على فهم القيمة الحقيقية للأشياء، لذا يُخطىءُ تاليًا في شكل كبير بهذا الحساب".
وتُُفيدُ الرواية الإنجيلية هنا بأنّ بعض الأمور الجوهرية، بما فيها ما يتعلّقُ بالله، لها منطقيًا تفضيلٌ على الفقراء، وتؤكد أن ما هو جيد هو الإنفاق بهدف العالم الآخر، وتاليًا من أجل الفقراء عموماً، أولئك الذين أخرجوا من عالم المال والجشع لأنهم مستبعَدون من شبكة تبادلات الاقتصاد المالي، وليس في قدرة هذا العالم إعادة الإعطاء إلى الفقراء لأنه إعطاء لله. وتوردُ الأناجيلُ أيضًا تقديم الهبات إلى الهيكل بحسب الطقوس اليهودية، لم يُنتَقَد أبداً. فالأرملة الفقيرة تأخذ من حاجتها الضرورية لتُعطي، ليس إلى من هو أفقر منها، بل إلى الهيكل، اي الله. (لوقا 21: 1-4) ، ولاقى عطاؤها هذا استحسان يسوع بقوّة".
ومهما تكنْ البادرة، فضروري أن تتمّ بهدف العالم الآخر، ما يعني محبة الله، من دون اكتراث لإرضاءات هذا العالم. فمَنْ يُعطِ الله بروح الغرور والتكبر والطمع، يجد جزاه في هذا العالم، ولا يُشكّل عطاؤه تاليًا "استثماراً" للعالم الآخر، فالله والمال سيّدان لا يلتقيان. فمَنْ يُعطي الهيكل، ويجد في عطائه إرضاءً لغروره، لا يُرضي كلاهما، ولا يفوزُ إلا بنصيبٍ في هذا العالم. فالسلوك الوحيد "الرابح" يكمن في عدم السعي إلا إلى العالم الآخر، مهما كانت البادرة. أو إذا كان العطاءُ لا يهدفُ إلى الحصول على مكافأة في هذا العالم، مثل العطاء إلى الفقراء، فيجبُ أيضاً ألاّ تكونُ غايةُ العطاء الظهور أو إرضاء غرور الذات. "أمّا أنتَ، فإذا تصدّقتَ، فلا تعلم شِمالُك ما تفعلُ يمينُك، لتكونَ صدقتُك في الخفية، وأبوك الذي يرى في الخُفية يجازيك" (متى 6: 3-4). وبالمثل للصلاة : و"إذا صلّيتم، فلا تكونوا كالمرائين، فإنهم يحبّون الصلاة قائمين في المجامع وملتقى الشوارع، ليراهم الناس. الحقّ أقول لكم إنّهم أخذوا أجرهم (متى 6/ 5)، وإذا صمتم فلا تعبسوا كالمرائين، فانّهم يكلّحون وجوههم ليظهروا للناس أنهم صائمون (متى 6: 16). ولكن إذا كان كل شيء يتم في الخفاء، ما يعني، من خلال التنظيم لتجنب أي مكافأة في هذا العالم، فعندئذ فقط يجازينا الله.
ليس لثروة هذا العالم معنى إلاّ بالنسبة إلى اللعالم الآخر
ومهما كانَ فعلُ العطاء فإنّه يدور في فلك المنطق الاقتصادي البحت، من حيث العقلانية، فالعطاء هو الاستثمار في العالم الآخر. في المقابل يجب التخلّص من جاذبيّة ثروات هذا العالم، من مملكة "مامون" (المال)، ما يؤدي إلى استخدام المال لأغراض تختلف عن أغراض هذا العالم وأهدافه، ما يعني حتمًا العطاء. إنّ الغني بالمعنى السيّء هو من يُعطي هدفًا واحدًا لمفهوم استخدام الثروة، الهدف المعطى لها في هذا العالم. من هنا تبكيتُ يسوع للأثرياء: "ويل لكم أيها الأغنياء فقد نلتم عزاءكم" (لوقا 6/ 24).
يمكنُ من خلال الأمثال الثلاثة التي ضربها يسوع عن الوكيل الخائن وأصحاب الوزنات أو الأَمْناء وفعلة الساعة الحادية عَشْرَة، المتناقضة ظاهريًا، تحديدُ مفتاحٍ واحدٍ لفهمها. ففي مثل الوكيل الخائن يأتي الجواب مباشرةً في نهايته:"إصنعوا لكم أصدقاء بالمال الحرام"، ما يعني: أعطوا المال. ويدعو يسوع في مثل الوزنات إلى عدم تجميد الثروة مهما كانت، بل إلى استخدماها وإنفاقها واستثمارها. المال موجود لاستخدامه جيّدًا.
و"يهدفُ مثل عمّال الساعة العاشرة إلى العطاء وفقَ مبدأٍ واحدِ، بعد أن يكون المرْء حققَ التزاماته القانونية، فالعطاء مبدأ الخير. تربط بين الأمثلة إذًا نقطة مشتركة: العطاء والكرم. ما يعني على مستوى بدائيّ وغير كافٍ، على رغم أن له قيمة في مجاله، مجال الاقتصاد: تفضيل الاستثمار على التكديس، تعهّد العمل بدل المواقف السلبية. ما يعني على المستوى الأعلى لـ"اقتصاد" العطاء: استخدام هذه الثروات واسعًا في مجال أعمال الخير والعطاء. ويبقى دائمًا المنطق الاقتصادي سليمًا على نحو مضاعف: على مستواه المأمور، ومن ثمّ أكثر عمْقًا، من خلال منظور العالم الآخر. وفي هذه الحالة، عُدِّلت نتائج العملية جذرياً. فمنظور العالم الآخر لا يدعونا فقط الى "اقتصاد" آخر، اقتصاد هبة الله اللامتناهية، بل يقودنا الى عيشه قدر المستطاع بدءاً من هذا العالم. إنّ العالم الآخر موجود بمعنى ما، وهو يهيكل أفعالنا في هذا العالم".
و"يهدفُ مثل عمّال الساعة العاشرة إلى العطاء وفقَ مبدأٍ واحدِ، بعد أن يكون المرْء حققَ التزاماته القانونية، فالعطاء مبدأ الخير. تربط بين الأمثلة إذًا نقطة مشتركة: العطاء والكرم. ما يعني على مستوى بدائيّ وغير كافٍ، على رغم أن له قيمة في مجاله، مجال الاقتصاد: تفضيل الاستثمار على التكديس، تعهّد العمل بدل المواقف السلبية. ما يعني على المستوى الأعلى لـ"اقتصاد" العطاء: استخدام هذه الثروات واسعًا في مجال أعمال الخير والعطاء. ويبقى دائمًا المنطق الاقتصادي سليمًا على نحو مضاعف: على مستواه المأمور، ومن ثمّ أكثر عمْقًا، من خلال منظور العالم الآخر. وفي هذه الحالة، عُدِّلت نتائج العملية جذرياً. فمنظور العالم الآخر لا يدعونا فقط الى "اقتصاد" آخر، اقتصاد هبة الله اللامتناهية، بل يقودنا الى عيشه قدر المستطاع بدءاً من هذا العالم. إنّ العالم الآخر موجود بمعنى ما، وهو يهيكل أفعالنا في هذا العالم".
الفصلُ الخامس
العلاقة الصحيحة بين العالمين
المسار العلوي لنبذ الثروة والتخلي عنها
"بالنسبة إلى الله الأغنياء والفقراء متساوون في الروح، في النفس. لكن بطبيعة الحال لا يقلُّ اقتناء الممتلكات خطورةً، كما يتضح في حال الشاب الغني. فهو لم يستطع أن يتخلّى عن الثروة الكبيرة ليتبع يسوع، أو لـ"يخلص"، على رغم أنه يريد أن يكون قدوة. لكن في حالته، كان يجب أن يبيع جميع ممتلكاته بحسب ما يطلبه منه الله. فالانبهار بثروات هذا العالم المستعملة من قبل الشيطان لهذه الغاية، له علاقة وطيدة مع الأهميّة الكمية لهذه الثروات. فالأغنياء، بالمعنى المتعارف عليه، معرَّضون لخطر كونهم أغنياء فينطبقُ عليهم مثلُ "ثقب الإبرة". في حين أنّ القديس بطرس ورفاقه تركوا كل شيء ليتبعوا يسوع ويمجدوه وهو أعلن لهم أنهم سيرأسون معه في مقام رفيع في يوم الدينونة الأخير، مشتركين في الحكم أيضاً. وذهب يسوع أبعد من ذلك فأوضح لهم، أنَّ كل من ترك بيوتاً أو أخوة أو أخوات أو أبا أو أما أو أبناء من أجل اسمه، ينال مئة ضعف ويرث الحياة الأبدية (متى 19: 27-29)، بحيث يوازي بين العائلة والخيرات الأرضية والثروات فيضعها في المستوى ذاته، ما يقودُ إلى نتيجتين: أولى تقضي بتخلص الإنسان من كل القيود الدنيوية وليس فقط المادية، ما يعني أن يتغير من داخله، فيتحول نحو القداسة. وفي هذا المجال حدّد يسوع أن التخلي يكون باسمه وحين يطلبه. أما النتيجة الثانية فتتلازم بين عدم إمكان التخلّي عن العائلة من حيثُ المبدأ (الإبن الضال)، وعدم التخلي عن الثروات أيضاً. فالعائلة والمال تتوازيان في اللجوء إليهما واستخدامهما، او التخلي عنهما بحسب ما يطلبه يسوع، وما يخطّطه لنا واحتياجات خلاص أنفسنا.
فالتسليم الكامل هو بالتأكيد الطريق الأسلم، طريق الكمال الممكن وهذا هو بالفعل المثل الأعلى للرهبانيات. فالامتثال الكامل مع العقلية الاقتصادية، ولكن بلا شك، مع إدخال ثابتة أساسية تغيّر كل شيء، هي العالم الآخر والمحبة اللامتناهية لله. فيسوع الذي لم يكن له حجرٌ لإراحة رأسه، أُخِذتْ ثيابُه منه أيضًا فاقتُسمتْ واقتُرع عليها (متى 27/35). وهذا هو موقف الرسل: في قصة الصيد العجائبي الذي يُنشىء العلاقة بين يسوع ورسله، أظهر يسوع قدرته في العالم المادي حيث أعطى وفرة الخيرات لهؤلاء الرجال، الذين كانوا يبحثون عن خيرات أرضية، على شكل صيد وفير حيث كادت شباكهم تتمزق. من هنا أصيبوا بدهشة لأنهم اكتشفوا بعداً آخر، ما دفع بطرس إلى الارتماء على رجليه للسجود والاعتراف بأنه مجرد صيّاد خاطئ، فما كان من يسوع إلا أن غيّر حياته وأعلنه من الآن وصاعداً صيادًا للبشر. فكانتْ النتائج بأن "تركوا كل شيء ليتبعوه بما فيه الصيد وخيراته". (لوقا 5: 6-11) من هنا بدأتْ فكرة الشركة في كل شيء (أعمال الرسل 2:44 -45)، فكان المؤمنون كلهم متحدين يجعلون ما عندهم مشتركًا في ما بينهم، يبيعون أملاكهم وخيراتهم ويتقاسمون ثمنها على قدر حاجة كلٍّ منهم. فما كان أحد منهم في حاجة. (أعمال الرسل 2: 32) وهذا ما يرسم صورة ما يسمى بالدير لاحقاً".
عدم القلق في شأن الحياة المادية
عدم القلق في شأن الحياة المادية
والمفارقة الرائعة في هذا المعنى هي التوصية بعدم القلق على الحياة المادية، بما فيها الطعام أو الملابس، لأن الروح تستحق أكثر من الطعام والجسد أفضل من اللباس. والمثال المُعطى للطعام هو مثال طيور السماء، التي لا تزرع ولا تحصد، ولكن الله يقيتها: "ألا نستأهل نحن أكثر منها"؟ ومن "الذي يستطيع من خلال أفكاره أنْ يُضيفَ لحظة واحدة الى حياته"؟ والملبَسُ هنا، هو من زنابق الحقل، التي لا تُخيَّط ولا تُنسج، إنّ "سليمان في كل مجده كان يلبس كواحدة منها". بعبارة أخرى، ليس سيئاً أن تلبس جيداً، ولكن يجب أن يكون للِّباسِ مفهومٌ كهدية بَحت ومجانية من الله جيّدة لأن هو منْ يُقدّمُها، ولا قيمةَ لها سوى من هذا المنظار. فنحنُ أفضل بكثير من تلك الطيور أو النباتات، وإذا كان الله يُلبِس حتى العشب الذي يَيْبَسُ غداً ويُحرق، فكم يفعل أكثر من هذا لكم، أيها الرجال القليلي الإيمان، كما يقولُ يسوع ؟ ما يعني بخاصّةٍ أنْ لا داعي للقلق في شكل مفرط من الغد، وبما فيه موقعنا الماديّ، واحتياجاتنا من مأكلٍ وملبسِ. وبالطبع لا يقتضي، بحسبِ يسوع، أن يَهيمَ المؤمنون على وجوههم مثلَ كائنات متهوّرة ومن دون فكر. فالعقلانية الاقتصادية تدوم، كما يدومُ التروي الحكيم والعقل. يقولُ يسوع: "لا تهتموا فتقولوا: ماذا نأكل أو ماذا نشرب؟ أو ماذا نلبس؟ فهذا ما يسعى اليه الجميع. وأبوكم السماويّ يعلم أنّكم تحتاجون الى هذا كلّه. فاطلبوا أوّلاً ملكوته وبرّه، تُزادوا هذا كلّه. لا يهمّكم أمر الغد، فالغد يهتمّ بنفسه. ولكلّ يوم من العناء ما يكفيه ... (متى 6: 25 -34 ، لوقا 12: 22 -31) وتبدو العبارةُ الأخيرة أكثرَ وضوحاً، فما يهم هو تجنب القلق المفرط في كيفيّة الحصول على احتياجاتنا الحياتية في هذا العالم، بحيث يسيطر علينا في نهاية المطاف.
يوضحُ بولس في رسالته الأولى إلى قورنتس (7: 32 – 34) انه من الأفضل أن لا يكونَ لنا همٌّ غير الله فيقولُ: " في ودّي لو كنْتُم من دونِ همٍّ، فإنَّ غير المتزوّج يصرفُ همّهُ إلى أمور الربّ والوسائل التي يُرضي بها الربّ. والمتزوّجُ يصرفُ همّه إلى أمورِ العالم والوسائل التي يُرضي بها امرأته، فهو منقسم. وكذلك المرأة غيرُ المتزوّجة ومثلها الفتاةُ، تصرفانِ همّهما إلى أمور الرب لتكونا مقدّستين جسدًا وروحًا، وأمّا المتزوّجةُ فتصرفُ همّها إلى أمورِ العالم والوسائل التي تُرضي بها زوجها". وهذه توصياتٌ لعدم التعلّق بالثروة والعائلة. فمن يتزوّج يصبح لديه همّ الزوج أو الزوجة ويتوزّع تاليًا بين هدفين. وتبقى النقطة الأساس ذاتها: يتعين تركيزُ المؤمن في شكل خاص على هدف واحد ذي قيمة أي الحياة ما بعد هذا العالم. فإذا كانَ يقلق في شأن غَدِه الماديّ، فهو ينسى تاليًا القلق الحقيقي الوحيد، المتمثّل في العالم الأخرى. ولذا "اختارتْ مريم أختُ مرتا النصيبَ الأفضلْ"، لا لأنَّ مرتا لم تهتم بيسوع، بل لأن اهتمامها أقلّ من اهتمام مريم الروحي، بحيث يبقى كلّ شيء قياسي ونسبي. فهذا "الكلُّ" يأتي في نهاية المطاف من الله، ما يهم هو أن نحبّه، وليس القيام بعمليات حسابية للهبة المقبلة. وأن نفهم أنه إذا فقدنا ما لدينا من أجله، فلهدف أسْمى، مثل تلاميذ يسوع مع شباكهم، يتركونها ليصيروا صيادين للناس.
التخلّي عن الذات واتّباع الله
"في النهاية، من هنا يبدأ الدرس الأول للمسيحية، فيذهب إلى أبعد من إطار المادة: إذا كنت تريد أن تتبعني، تخلَّ عن نفسك. فالمشكلة مع الثروة المادية أنها تجعل المرْء ينطوي على ذاته. لذا ترتكزُ النقطةُ الأساس على وجوب التخلّي عن النفس وحمل الصليب واتباع يسوع الذي قال إلى تلاميذه: "منْ أراد أن يتْبَعْني، فليَزْهدْ في نفسه ويحملْ صليبهُ ويتبعني، لأنَّ الذي يُريدُ أن يُخلِّصَ حياته يفْقِدُها، وأمّا الذي يَفْقِدُ حياته في سبيلي فإنَّه يجدها. ماذا ينفعُ الإنسانَ لو ربح العالم كلّه وخسِرَ نفسه؟ وماذا يعطي الانسانُ بدلاً لنفسه"؟ (متى 16: 24 – 26)
المهم في الحياةِ المسيحية اتِّباع يسوع. وهذا ما يُكنّى عنه في الواقع بالاستعارات الاقتصادية، لأنها الوسيلة الوحيدة لنكون منتجين. وتوجدُ وفي ضوئها علاقة مباشرة بين المردود المنتظر من شخص ما، ونوعية العلاقة التي بناها هذا الشخص مع الله: "كلّ غرسٍ لم يغرسْه أبي السماويّ يُقلع". (متى 15: 13) ولكن إذا لم يكن منتجاً، فلأنه لم يُروَ من شجرة الحياة. فمن خلال البقاء متصلين أو مزروعين في الآب، يُمكن أن نُنتج ثمرًا مجدياً. تلعبُ الاستعارة الاقتصادية الزراعية هنا، دوراً حسيًّا وجذريًّا، إما أن يتمّ الريُّ بالله ومن عنده، وإما يكون العقم وفي نهاية المطاف يكون النَبْذُ.
يروي يوحنا عن يسوعُ قوله: "أنا الكرمة الحقّ وأبي هو الكرّام. كلّ غُصْنٍ فيَّ لا يثمرُ يفصِلُه. وكلُّ غُصْنٍ يُثمر يقضِّبُه ليَكْثُرَ ثَمَرُه... وكما أنّ الغصنَ، إنْ لمْ يثبتْ في الكرْمَةِ لا يستطيعَ أنْ يُثمر من نفسه، فكذلك لا تستطيعون أنتم أن تُثمِروا إنْ لم تثبتوا فيّ. أنا الكرمة وأنْتُمُ الأغصان. فمن ثبت فيّ وثبتُّ فيه فذاك الذي يُثمِر ثَمراً كثيراً. لأنكم بمعزل عني، لا تستطيعون أن تعملوا شيئاً. ومنْ لا يثبُتْ فيَّ يُلْقَ كالغصنِ إلى الخارج فييبس، فيجمعون الأغصانَ ويُلقونها في النار فتشتعل". (يوحنا 15: 1-6)
ما لا يلغي الاقتصاد، ولكن يخضعه
ما يهمُّ في بشارةِ يسوع وتعاليمه، ليس التخلي عن كل حساب بشري عقلاني، عن التفكير في الغدِ أو اتخاذ جانب الحذر، بل على العكس. لا توجدُ دعوةٌ للاكتناز في هذه الحياة على الأرض، بل توجبُ التدابيرُ اليومية تحقيق الوفرةِ والادخار إذا أمكنْ، من أجلِ السعي إلى العطاء وأعمالِ الخير. وكان ليسوع وتلاميذه صندوق ادخار من أجل الإنفاق اليومي، ولولا الإدخار لم تستطع التائبة (مريم) من شراء عطرٍ غالي الثمن لتطييب جسد يسوع في الحياة، ولا استطاعت النسوةُ شراءه لدى زيارتهنَّ قبر يسوع في اليوم التالي لدفنه بحسب جري العادة. كما لم يمنع يسوع زكّا من الاحتفاظ بنصف ثروته... وتُمكن المُلاحظةُ بحسب هذه الروحيّة، أنَّ ما جمعه رسلُ يسوع في بداية تبشيرهم، لم يقدهم إلى تبديد هذه الأموال ووهبها إلى الفقراء في الخارج، ليضعوا ذاتهم في ما بعد تحتَ رحمة العناية الإلهية، ما يجعلُ من مفهوم مَثَلِ زنابق الحقول فهمًا سيئًا، ولكن ستتمُّ معًا إدارة هذه الأموال والتصرّف بها من دون دوافع للربح، وقد أُعطي جزءٌ منها للفقراء. "وكانَ جماعةُ الذين آمنوا قَلْبًا واحدًا ونَفْسًا واحدةً، لا يقولُ أحدٌ منهم أنّهُ يملكُ شيئًا من أمواله، بل كانَ كلُّ شيئٍ مشترَكًا في ما بينهم، وكان الرسُلُ يؤدون الشهادةَ بقيامةِ الربِّ يسوع تصحبها قوّةٌ عظيمة، وعليهم جميعًا نعمةٌ وافرة. فلم يكن فيهم محتاجٌ، لأن كلَّ من يملكُ الحقولَ أو البيوتَ كانَ يبيعها، ويأتي بثمنِ المبيع فيُلقيه عندّ أقدام الرسل فيُعطى كلٌّ منهم على قدْرِ احتياجه. (أعمال 4: 32 – 35) وهكذا فإن بطرس ويوحنا لم يستطيعا أن يعطيا المُقْعَدَ فضةً وذهبًا لأنهما لا يملكانهما بل أعطاه بطرس "ما عنده"، أي الإيمان بيسوع فقال له: "باسمِ يسوع الناصري امشِ". (أعمال 3: 4 -8)
وكانَ يسوعُ قال إلى الرُسل: "هاءنذا أرسِلُكم كالخراف بين الذئاب: فكونوا كالحيات حاذقين وكالحمام ساذجين. احذروا الناس ... (متى 10، 16-17). أما المطلوب فهو التخلي عن التعلق بالممتلكات، والقلق على الأموال. ويُضيفُ لوقا توصياتٍ لمْ يذكرها متى، تتعلّق بإنفاق الرسل الاثنين والسبعين خلال تجوالهم للبشارة فيضيفُ يسوع: "لا تحملوا كيسَ دراهمَ ولا مِزْودًا ولا حِذاءً ولا تُسلّموا في الطريقِ على أحد"... وأيَّ بيتٍ دخلتم أقيموا فيه "تأكلونَ وتشربونَ ممّا عندهم لأنّ العاملَ يستحقَّ أجرته. (لوقا 10: 4-7)
في النهاية يتخلّى تلاميذُ يسوع عن أموالهم من أجله، ومثلهم المؤمنون تطبيقًا لقول معلمّهم "كلّ واحد منكم لم يتخلَّ عن جميع أمواله لا يستطيع أن يكون لي تلميذاً" (لوقا 14، 33)، وهو استنتاج ناتج عن حساب عقلانيّ محض، إذ يجب أن يعرف الإنسانُ ما يريد، ويُحدد الوسائل الضرورية لذلك.
لكنَّ يسوع لا يُلغي المكافآت المادّية في هذا العالم. ففي توجيهاته التي أعطاها إلى الرسل، أوضحَ أن شقاءهم يستحق أجراً، بما فيه الأجر المادي بقوله لهم: "إنّ العامل يستحقَّ أجرته". وأجرى يسوع عجائب لها طابعٌ مادي صرف مثل صيد الأسماك، تكثير الخبز، تحويل الماء إلى خمر... لكنَّ المهم في حياة المؤمن عدم السعي إلى الحصول على المنافع المادية لذاتها فقط، وبخاصةٍ عدم التمسك والتعلق بها. فتلاميذ يسوعُ لا يترددون في الشراب والطعام، بينما يضع أعداؤه أو غيرُ المؤمنين به، سلوكهم في تناقض مع الزهد المبالغ لتلاميذ يوحنا المعمدان. (لوقا 5/ 33) وبرّر يسوع تصرف تلاميذه ( في ردّه على سؤال تلاميذ يوحنا: "لماذا نصومُ نحنُ والفرّيسيون وتلاميذك لا يصومون"؟) بالتأكيد أنَّه لن يكون دائماً مع تلاميذه، وأنّ ما من أحد يجعل الخمرة الجديدة في زقاق عتيقة، لئلاّ تشقّ الخمرة الجديدة الزقاق فتراق هي، وتتلف الزقاق. قال لهم يسوع: "هل يستطيع أهلُ العُرسِ أنْ يحزنوا ما دامَ العروسُ بينهم؟ ولكنْ تأتي أيّامٌ فيها يُرفَعُ العريسُ من بينهم فحينئذٍ يصومون. ما من أحدٍ يجعلُ في ثوبٍ عتيق قطعةً من نسيجٍ خام، لأنها تأخذُ من الثوبِ على مقدارها، فيصيرُ الخَرْقُ أسوأ. ولا تُجْعَلُ الخمرةُ الجديدة في زِقاقٍ عتيقةٍ، لئلاّ تنشقَّ الزِّقاقُ فتُراقَ الخمرُ وتَتْلَفَ الزقاق، بل تُجعلُ الجديدةُ في زقاق جديدة، فتَسْلمُ جميعًا". (متى 9: 14 -18، لوقا 5: 33 – 39، مرقس 2: 18-22) فليس المهم إذًا التطبيق التلقائي والحرفي للشريعة، بل للروحية الجديدة، التي تستبعد المكافأة الماديّة. وهذا ما يدفع يسوع، خلال إرسال تلاميذه للتبشير، إلى أن يطلب منهم شفاء المرضى، والعطاء مجاناً لأنهم أخذوا مجاناً، وأن لا يقتنوا نقوداً، ولا مزوداً للطريق ولا قميصين احتياطاً، لأنّ كلّ عامل يستحقّ طعامه. ويطلبُ يسوع كما ينقلُ لوقا، إلى تلاميذه أن يمكثوا في المنزل ذاته "تشربون وتأكلون ممّا عندهم فيه، لأن العامل يستحق أجرته. ولا تنتقلوا من بيتِ إلى بيتٍ" (لوقا 9/7)، بهدف التفرّغ للرسالة تفرّغًا تامًا وليس للبحثِ عن ضيافةٍ مريحة.
أَعِد لقيصر ما لقيصر
يُشكّلُ أحد تعاليم يسوع الأكثر شهرةً، حولَ موضوع قطعة النقود المعروفة بـ"دينار قيصر"، مفتاحً جديدًا في مضمونه الشهير: "أعطِ لقيصر ما لقيصر، ولله ما لله" (متى 22، 15-22 ؛ لوقا 20، 21-25). فالمقاربة هنا أبعد مما يربطه الشارحون بـ"فصل عالم السياسة عن عالم الدين". بلْ يريدُ يسوع من المهتمّين بما إذا كانوا يجوز أنْ يدفعوا الضريبة إلى قيصر أم لا، أنْ يهتمّوا بانتمائهم الحقيقي إلى الله "الخالق". إن قيصر روما هو من يضع في هذه الحياة الدنيا صورته على النقود وكتابةً تعودُ إليه، بينما الإنسانُ هو صورةُ الله "التي خلقها على مثاله. "فخلقَ الله الإنسانَ على صورته، على صورةِ الله خلقه، ذكرًا وأنثى خلقهم (تكوين 1: 27). وأمّا كتابة الله فهي وصاياه.
وعلاوةً على التطبيق الشرعي للعبارة على الصعيد السياسي، يوجد بوضوح في المقابل تطبيقٌ آخر على الصعيد الاقتصادي يقضي بضرورةُ إعادة الاحترام الجدير بالاعتبارات الاقتصادية، في نطاقها الخاص. لكنَّ هذا النطاق يتمايز في عقلانيته الخاصة، عن نطاق الله، الذي يجب أن يشكّل وحده محور اهتمامنا الحقيقي، محور قلوبنا. هكذا تقتضي الحكمة، هذا ما تُعلِّمُنا إيّاه بامتياز.
هنا ينبغي بالطبع تجنب أي خلطٍ بين النوعين، وفي حال حصول أي نزاع، يجب أن يتمّ حلّه لصالح الاعتبار الوحيد الأسمى، اعتبار العالم الآخر. ومن مفهوم هذه المسلّمة طرد يسوع الباعة من الهيكل بلا رحمة (متى 21: 12-13)، "بيتي بيت صلاة يُدعى، وأنتم تجعلون منه مغارةً للصوص". ويمكن أن تعني "ثورةُ" يسوع في هذا الإطار التحضير للمهمة التي سيوليها إلى تلاميذه، بحيث لا يجب الأخذ فقط بالجهوزية، بل ببيع اللباس لشراء السيف. قال يسوع لتلاميذه: "حين أرسلْتُكم بلا كيسِ دراهم ولا مِزْود ولا حذاء، فهلْ أعوزكم شيء؟ قالوا: "لا". فقال لهم: "أمّا الآنَ فمنْ كانَ عنده كيسُ دراهمٍ فليأخذه. وكذلك منْ عنده مِزود، ومنْ لمْ يكن عنده سيفٌ فَلْيَبِعْ رِداءَه ويشْتَرِه (لوقا 22: 35 – 36). وبعبارة أخرى، يمكن أن يتعيّن الخروجُ من الرؤية الاقتصادية ومفهومها، للوصول إلى مرحلة الانقطاع والنضال، بخاصةٍ ضدَّ الذات.
وضع أولويات العالمَين في داخلنا:
أن نتحول ونَرتدّ داخلياً
"توجد هذه المفارقة الأساسية والتراتبية، في الفصلِ بين الأدوار والمهمّات، بما فيها الأدوار الأكثر ضرورة. بخاصةٍ إذا كان التحليل العملي الحريص، إضافة إلى العمل المادي، يحافظان على قيمتهما الكاملة: فالطريق الى الملكوت هي طريق المحبة. فبين مرتا التي تعمل بجهد ومريم التي تتأمل يسوع من دون أن تعملَ أمرٌ محسوسٌ، وعلى رغم اعتراض مرتا التي أرادت أن يتدخّل يسوع لتقوم مريم بمساعدتها، فإنَّ هذه الأخيرة "حصلت على النصيب الأفضل، ولن ينزع منها أبدا". لأنه كما قال لها يسوع: "مرتا، مرتا، إنّك في همّ وارتباك في أمور كثيرة، مع أنّ الحاجة الى أمرٍ واحد" (لوقا 10: 38-42). ويُلاحظ أنّ مريم كانتْ لاقتْ يسوعُ عندما ذهبَ ليقيمَ شقيقها لعازر من الموت، ولمْ ترافقْها مريم، "فلمّا سمعتْ مرتا بقدوم يسوع خرجَتْ لاستقباله في حين أنّ مريم بقيتْ جالسة في البيت" (يوحنا 11/20)، وفي موقعٍ آخر تتعرّف مرتا وحدها في الإنجيل كلّه ومع بطرس إلى يسوع على أنّه ابنُ الله، وبعبارةِ أخرى "الله". تنادي مرتا يسوع: "يا ربّ، لوكنتَ ههنا لما ماتَ أخي، ولكنّي ما زلتُ أعلم أنَّ كلَّ ما تسأله الله، فالله يُعطيكَ إيّاه" (يوحنا 11/21). وما قالته كان محسوسًا وإيجابيًّا... ما يُثبت أن العملَ الملموس لا يُبطلُ عملية الخلاص، شرط أن تكون تراتبية الأولويات واضحة جداً".
الفصل السادس
مفارقات ظاهرة
تأخذُ هذه الاستنتاجات منحىً مخالفًا للرأي العام قياسًا إلى الأخلاقية الاقتصادية المعروفة، في ضوء النتائج الملموسة لتكوينات محدّدة.
" من له يعطَ، من ليس له يؤخذ منه ما له"
يؤكّدُ هذا المثل أهمّية المواهب، نظرً إلى أنَّ من لا يملكُ غيرَ القليل يُنزع منه ليُعطى إلى من يملك الكثير. تصدمُ هذه الأمثولة الأخلاقية بعفويتها. لكنها منطقية وصحيحة وعادلة من منظور جديد ومنفتح يدعو إلى الكرم، إضافة إلى أنَّها تذكّر بالتفاوت العميق الموجود بين الناس في وجه الخلاص، بمن فيهم الذين تم خلاصهم. وتسلِّط الضوء أيضًا على الثروة غير القابلة للاستبدال: ما يعني الثروة الموجهة نحو هذا العالم أو الثروة الموجهة إلى العالم الآخر، لأن النتيجة النهائية لأحدهما تختلف تماماً عن النتيجة النهائية للآخر. فمن هو كريم ويُكدّس الثروات بمعنى الملكوت، يحصل تاليًا على المزيد والمزيد، ومن يترك ثروته عقيمة لأنه يريد أن يصونها، يَرَ أنها تُنزع منه. وفي مثال المزارع نجد هذه الجملة: "لأنّ من كان له شيء يُعْطى فيَفيض. ومن ليس له شيء، يُنتزعُ منه حتى الذي له" (متى 13/12). ويُحتّمُ الامتلاك هنا بالتأكيد وجود ما يكفي للسماح للكلمة الجيدة الصالحة لأن تحيا وتثمر. لأنها في مكانٍ آخر من متى (25/29)، تعني الاقتصاد المقصود به تشبيه الدينونة. فمن يتلقَّ يحصلْ على المزيد، ومن يرِد الاحتفاظ بممتلكاته تُنزع منه. كما في حال الكرّامين القتلة، حيثُ يكونُ الكرم فوق كل اعتبار للمساواة (متى 21: 33-45). فالفقراء في ثرواتهم المادية قد يرون الله، أمّا المساكين في الثروات الروحية فلن يحصلوا على شيء، ويخسرون أيضاً ما لديهم. الله يعطي الكرماء ويأخذ من الآخرين. في الواقع من لا يمكنه أن يعطي لا يمكنه أن يأخذ. وهذه مسلّمة أخرى صحيحة على صعيد الوقائع الأساسية، وعلى المستوى الاقتصادي أيضاً.
" من أحبّ حياته فقدها، ومن رغب عنها في هذا العالم من أجلي، حفظها للحياة الأبدية" (يوحنا 12: 24-26)
وقيلَ أيضاً في مكان آخر: "انّ حبّة الحنطة التي تقع في الأرض، إن لم تمت تبقَ لوحدها. وإذا ماتت أعطَتْ ثمراً كثيراً". لا يوجد في المثل قفزٌ نحو اللامنطق، فمَنْ يُريد أن يحبّ نفسه هو هنا من لم يفهم شيئاً، ويظلّ متعلقاً بغروره، ويريد أن يصونه، في نطاق تكديس المال في هذه الحياة على الأرض. أمّا من يخسر نفسه من أجلِ يسوع، فلا يعني أنّه يقبل بالضرورة أنْ يُلعنَ فقط من أجل المسيح، سيكونُ الأمرُ غباءً. ولكن من يتخلّى عن غروره، يقبل بأن يكون مثل الطفل الصغير، وإلا لن يدخل ملكوت السموات. المفهوم منطقي اقتصادياً بالنسبة إلى حبّة القمح، فلكي تُثمر يجب أن تموت... وبالروحيةِ ذاتها يجب أن نبذل حياتنا في سبيل من نحبّ (كما قيل في رسالة يوحنا الاولى 3: 16 -17)، وبالمثل من يملك الوسائل المادية ويغلق قلبه عند رؤية أخاه في حاجة إليه، لا يمكن أن تكون محبة الله في قلبه. فالحبُّ لا يجب أن يكونَ بالكلمات بل بالأفعال والحقيقة. يقولُ يوحنّا في رسالته: "وإنّما عرفنا المحبّة، بأنَّ ذاك قد بَذَلَ نفسه في سبيلنا. فعلينا نحنُ أيضًا أن نبْذُلَ نفوسنا في سبيلِ إخوتنا. منْ كانتْ له خيراتُ الدنْيا ورأى لدى أخيه حاجةً فأغلَقَ أحشاءهُ دونَ أخيه، فكيفَ تُقيمُ فيه المحبّة"؟ ويقابل ما ورد في الرسالة، كلامٌ ليسوع في إنجيل يوحنا عن الراعي الصالح الذي يبذلُ نفسه في سبيل الخِراف (10/11 و15)، وفي بذْلِ النفس إحياءٌ لها ثانيةً (10/17)، فـ"ما من أحدٍ ينتزِعُها منِّي بل إنّي أبذلها برِضاي. فلي أن أبذلها ولي أن أنالها ثانيةً" (10/18)، وهذا ما يتلاقى مع قوله أيضًا: "لأنّ الذي يُريدُ أن يُخلّصَ حياته (نفسه) يفقِدُها، وأمّا الذي يَفْقِدُ حياتَه في سبيلي فإنّه يجدها" (متى 16: 25).
" نحن خدام غير نافعين "
هذا ما لم يفهمه عمال الساعة الأولى الذين استأجرهم "ربُّ بيتٍ خرج باكرًا، ليعملوا في كرمه(متى 20: 1 -16). هؤلاء اعتقدوا بحسب مفهوم عقود العمل، أنّهم سيتقاضونَ أجرًا أكثر مما سيتقاضاه العملة الذين جاؤوا بعدهم على مدى النهار وحتى الساعة الخامسة بعد الظهر. جاؤوا ليطالبوا بما يستحقون. لكن ما هكذا يجب أنْ يتقدّموا من الله ويأتوا إلى الآب، لأنّهم تقدّموا مثل خدمٍ غير نافعين. بتعبيرٍ آخر حتى ولو كانت الهبة التي يقدّمها المؤمنُ عقلانية من الناحية الاقتصادية لأنها ستعاد إليه ألف ضُعفٍ، فلن تنجح إلا إذا نفّذها بروحيّة منْ لا يحسبُ حسابًا لمردود، على عكس يهوذا تماماً. ويظهر أيضًا خطأ مماثل آخر ولكن أكثر أهمية، هو خطأ الأخ الأكبر للإبن الضال، عندما يغضب لرؤيته أباه يحتفلُ بعودةِ أخيه، كما لم يحتفلْ يومًا له طيلة إقامته معه، بخاصةٍ أنه لطالما عمل وأطاع أباه كما يجب. وعلى رغم أنَّ والده يعترف بفضائله، وأنّ "جميعَ ما هو لي هو لكَ"، فإنَّ هذا الأب يذكّر ابنه الكبير بأن ما ينقصه هو الكَرَمُ، وتحديدًا تجاه أخيه. لأن الحقيقة الوحيدة لا تتجلّى في العمل في المزرعة ولكن في المحبة المتبادلة، وصُنعِ الخير بالمعنى الحقيقي للكلمة: "فهذا أخاك كان ميتًا فعاش وكانَ ضالاً فوُجِدَ ... وقدْ وجبَ أن نتنعّمَ ونفرّح". فحسابات الإبن البكر غير منطقية، لأنّه يفتقد إلى القلب. فلو أجرى هذا الإبن حساباته في شكل صحيح... لكفَّ عن الاحتساب الاقتصادي عندما بدأ في موضوع يتعلّق بالعطاء. من هنا هذا الإنقلاب في القرار المستخلَص من مَثل يسوع: "كثيرٌ من الأوّلين يصيرون آخرين، ومن الآخرين أوّلين" (متى 19/30، لوقا 13/30 ).
والأولون بحسب معيار هذا العالم، من حصّلوا مالاً أكثر من غيرهم وكسِبوا أمورًا مادية، ما يُعتبر في ذاته ثروة حقيقيّة، لكن يعرّضهم لخطر البقاء عند مستوى حسابات هذا العالم، مثل عمّال الساعة الأولى، وينتهي بهم الأمر ليصيروا آخيرين.
التطبيق العمليّ لهذا المفهوم أنّه لا يجب الاحتساب بدقة متناهية لمن يزرع ومن يحصد. وينقلُ يوحنا عن يسوع قوله بوضوح: "طعامي أن أعملَ بمشيئة الذي أرسلني وأن أُتِمَّ عمله". ومن حينه من يحصد يحصل على المكافأة ويكدّس للحياة الأبدية."هوّذا الحاصدُ يأخذُ أجرته فيجمع الثَّمرَ للحياةِ الأبدية فيفرحُ الزارعُ والحاصدُ معًا" وبذلكَ يصدقُ المثلُ القائل: الواحدُ يزرعُ والآخرُ يحصدُ. إنّي أرسلتكم لتحصدوا ما لمْ تتعبوا فيه. فغيركم تعبوا وأنْتم دخلتم ما تعِبوا فيه". (يوحنا 4: 34 - 38) وهنا ما يتوازى أيْضًا مع المنطق الحسابيّ المباشر لعمّال الساعة الأولى.
" إن لم ترجعوا فتصيروا مثل الأطفال،
لا تدخلوا ملكوت السموات"
"كل هذا لديه عواقب ونتائج مباشرة في ما يخص التراتبية البشرية: من أراد أن يكون كبيراً فيكم، فليكن لكم خادماً. ومن أراد أن يكون الأوّل فيكم، فليكن لكم عبداً. هكذا ابن الانسان لم يأت ليُخدَم، بل ليخدُم ويفدي بنفسه جماعة الناس (متى 20: 26-28). ويظهر هذا المشهد الغريب حيث يتجلّى عملُ يسوع في غسل أرجل تلاميذه ويطلب منهم القيام بالمثل:"فإذا كنت أنا الربّ والمعلّم قد غسلت أقدامكم، فيجب عليكم أنتم أيضاً أن يغسل بعضكم أقدام بعض" (يوحنا 13/14). وفي شكلٍ عام أكثر، من ينحني يُرفع إلى الأعالي ومن يرتفع ينحنى، وهذا ما يفسّره مثل الفرّيسي والعشار: "فالفريّسي انتصبَ (لمْ ينحنِ) قائمًا يُصلّي فيقولُ في نفسه: اللهمَّ، شُكْرًا لكَ لأني لسْتُ كسائر الناس السرّاقين الظالمين الفاسقين، ولا مثْلَ هذا الجابي. إنّي أصومُ مرّتين في الأسبوع، وأؤدّي عُشرَ كلّ ما أقتني. أمّا الجابي فوقفَ بعيدًا لا يُريدُ أنْ يرفعَ عينيه نحو السماء، بلْ يقرعُ صدره ويقول: اللهمَّ ارحمني أنا الخاطئ" (لوقا 18: 11- 12).
ويؤدي هذا المثل إلى خلاصة لافتة: "إن لم ترجِعوا فتصيروا مثل الأطفال، لا تدخلوا ملكوت السَّموات" (متى 18/3).
الفصلُ السابع
عالمُ الاقتصاد وعالمُ الله
كيف نرتدّ بينما نعيش في عالم الاقتصاد
ما الأمثولات التي يمكنُ أن نستخلِصها لأنفسنا ؟
المبدأ الأهم أن نتّجه أوّلاً وفي شكلٍ أساس نحو حقائق العالم الآخر ومنطقه، عالم الحياة الأبدية. فالمنطق الاقتصادي جدّ قويّ، ما يحتّمُ أن نبذل جهداً لنتحول في شكل جذري ونتفادي سحر خيرات هذا العالم وأنشطته، ونُركّز كلّما اقتضى الأمر، على الحقيقة الاساسيّة الوحيدة. بتعبيرٍ آخر، ما هو ضروريٌّ هو هذا الانعطاف الجذري للرؤية الداخلية.
فالغرض من تعاليم يسوع في المقام الأول، الحياة الروحية، شبّه طريقة سلوكنا نحوها في أمثالٍ رسم خلالها أيضًا البُعدَ في حياتنا على الأرض، وهو النشاط الاقتصادي. توجد دعوة خاصة وسامية تقودنا إلى التخلي الكامل عن كلّ الممتلكات المادية، مثل نداء الله عن الفقر المطلق. هذه حال الرهبان وهذه الحالة غير ناتجة عن التدقيق في الأمور. إنّ الصلة بالمال والحياة الاقتصادية تطرح ذاتها في هذه الحالة، بخاصة في الممتلكات المشتركة، ولكنها تأخذ منحىً ومعنىً مختلفين تماماً عمّا ينتجُ عن الانغماس في الحياة الاقتصادية.
يطرحُ يسوعُ في معظم أمثاله حالةَ منْ يؤمن به وبتعاليمه، ولا ينسحب من العالم، بل يجبُ عليه أن يجد الاتجاه المناسب. إنّ خلاصة تعاليم يسوع واضحة. تؤكّد من ناحية صحة الحقائق الأساسية للحياة الاقتصادية، لأنها تؤدي جزئيًا إلى المشاركة في تحوّل الخلق بطريقة مسؤولة، لأن خيرات هذا العالم أعطيت لنا شخصياً، لكن لنطوّر هذه الخيرات جماعيًا ونكثّرها مع الآخرين ومن أجل الجماعة. ويجبُ في الوقت ذاته أن نتحول جذرياً ونبتعد عن القانون المادي لهذا العالم وسطوته على نفوسنا. هكذا نشأتْ الجماعةُ المسيحيةُ الأولى كما يعرّفنا إليها لوقا في "أعمال الرسل" حيثُ يقول: "وكانَ جماعةُ الَّذينَ آمنوا قلبًا واحدًا ونّفسًا واحدة، لا يقولُ أحدٌ منهم إنّهُ يملكُ شيئًا منْ أمْواله، بل كانَ كلُّ شيئٍ مشتركًا بينهم، وكانَ الرسُلُ يؤدونَ الشِهادةَ بقيامةِ يسوع، وعليهم جميعًا نعمةٌ وافرة. فلمْ يكنْ فيهم واحدٌ محتاج، لأنّ كلّ من يملِكُ الحقولَ أو البيوتَ كانَ يبيعُها، ويأتي بثمنِ المبيع، فيُلقيه عندَ أقدام الرسل. فيُعطى كلٌّ منهم على قدْرِ حاجته" (أعمال 4: 32 – 35).
أمّا ما أصاب حَنَنْيا وزوجته سفيرة فماتا، فليسَ بسببِ اقتطاعِ جزءٍ من ثمنِ الحقل الذي باعاه، بلْ لكذبهما على بطرس الرسول، أنّهما القيا لديه كامل ثمن الحقل. أي أنّهما لم يبتعدا عن القانون المادّي لهذا العالم وسطوته على النفوس.
فالمعضلة الأساسية تتركّزُ في تفكيرِ المرء، عليه أن يُميز كيف يمكنه، رغم وجوده في إطار العالم الأرضي المادي، عالم المجتمع الدنيويّ الذي يعرفه، عالم الممتلكات والمبادلات المادية، أن يصنع في نفسه ولأجل الآخرين. هذا هو الانقلاب الداخلي الذي يدعو إليه يسوع.
سؤالٌ مزدوجٌ على الصعيدين الفردي والجماعي
لهذا السؤال مفهومان مختلفان: مفهومٌ ذاتي يتعلّق بكلٍّ منَّا سواء لناحية مسيرته وتوبته الشخصية التي تشملُ في أساسها تحوّلاً جذرياً في علاقتنا مع المال، وسواء في فعلنا الملموس حيثما وُجِدَ هذا الفعل، لأن في إمكان العلاقة مع المال والفعل تجاهه أن يؤديا إلى خيارٍ أساس في الحياة، وهو في أبعد الحالات دعوة إلى التخلي التام عن كل شيء. وتاليًا مفهومٌ جماعي يتعلق بالمجتمع، وبمقدار ما يستلهم المبادئ المسيحية، إما لأنه يتمنّاها في وضوح أو في شكلٍ غير مباشر لأن المسيحيين عند دخولهم عالم الأناجيل، يتصرفون في بيئتهم الاجتماعية أو على صعيد تشريعهم بهدف أن يقبلوا هذا المبدأ او ذاك أو يتبنوا تلك القيمة، وإنْ على حساب استحقاقهم الشخصي، بحسب مفهوم الأخلاق الطبيعية أو التحليل.
الاشتراك في:
التعليقات (Atom)